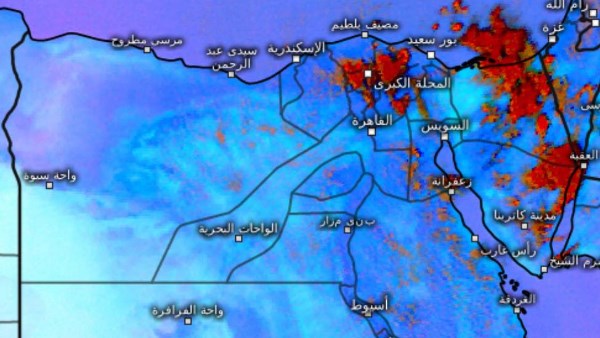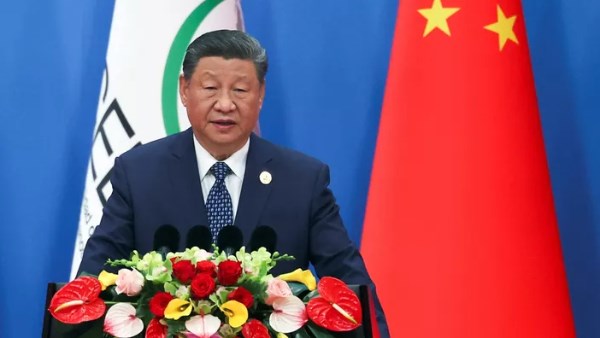قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن البعض قد يتحفظ على تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام، ويبادر إلى القول بأنه لا توجد مساواة بينهما في بعض الحقوق، مثل: القوامة أو قيادة الأسرة، التي جعلها الشارع حقا أصيلا للرجل دون المرأة، ومثل الميراث الذي يظهر فيه التفاوت والتفاضل بين الذكر والأنثى، ومثل اللامساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالقضاء، ومباشرة القتال في الحروب، وأمور أخرى تقول: إن «المساواة» في الإسلام بين الرجل والمرأة ليست مبدأ عاما لتقسيم الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء قسمة متساوية، مستدلين بقوله تعالى {وللرجال عليهن درجة}، وقوله تعالى {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
وأوضح شيخ الأزهر، في الإجابة على ذلك أن القرآن الكريم صريح في ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في كل شأن من شؤون الحياة يصلح له الطرفان، ويحقق فيه كل منهما ما يحققه الآخر سواء بسواء وتماما بتمام، هاهنا تصح المساواة، وتصبح حقا لكل منهما تقتضيه العدالة ويوجبه الإنصاف، كما يصبح التفاضل بينهما ظلما يضرب قيمة العدل والعدالة في مقتل.
وأوضح شيخ الأزهر، خلال الحلقة السادسة من برنامج "الإمام الطيب"، المذاع على قناة " "، بعنوان: "فلسفة المساواة في الإسلام"، أن بيان ذلك يحتاج إلى شيء من التعمق في فهم معنى «المساواة»، ومتى تكون المساواة «عدلا» وفضيلة من الفضائل ومتى تكون «ظلما» ورذيلة من الرذائل، فالمساواة التي يتحقق معها معنى «العدل» هي المساواة التي تكون بين متماثلين، كل منهم يساوي الآخر في استحقاق الوصف بالمساواة، فإذا كانت المرأة - مثلا- تساوي الرجل في أصل الخلقة، كما قرره القرآن في آيات كثيرة، فإن من «العدل» أن يتساوى في هذا الأصل كل من الرجل والمرأة، وبحيث يصبح من الظلم أن يصادر على المرأة حقها في مساواة الرجل بحجة أن الرجل يفضلها في هذه الحقيقة، وأنه لا مساواة بينهما في هذا الأصل.
وأضاف، أن هناك العديد من المجتمعات القديمة، والحديثة أيضا، نظرت إلى المرأة بحسبانها مخلوقًا تابعا للرجل، مسخرا لخدمته وخدمة أهله وأولاده، ولم تنظر للمرأة بحسبانها شقيقة للرجل ومساوية له في أصل الإنسانية، مضيفا أن المساواة التي يتحقق معها مبدأ العدل هي «المساواة» المشروطة بأن تكون بين طرفين يتماثلان في كل ما من شأنه أن يوجب لهما المساواة في هذا الوصف أو ذاك، أما المساواة بين المتخالفين فإنها لا تعدو أن تكون لفظا فارغا لا معنى له؛ لأن معنى "المتخالفين" أن أحدهما لا يساوي الآخر بحال من الأحول.
وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أن هذا النوع من التساوي بين المتخالفين هو في الحقيقة ظلم لطرف ومحاباة لطرف آخر.. والظلم والمحاباة رذيلتان تنفر منهما فطرة الإنسان السليم، وذوقه العام، ولكي نفهم فلسلفة «المساواة» في شريعة الإسلام، لا مفر لنا من أن نكون على وعي بالخلفية «الأخلاقية» الرابضة وراء كل تشريع من تشريعات هذا الدين الحنيف، سواء منها ما تعلق بجانب العبادات أو جانب المعاملات، موضحا أن فلسفة التشريع الإسلامي بينت لنا الربط القوي بين الأصل الخلقي من جانب، وما ينبني عليه من أحكام وتشريعات من جانب آخر، وبحيث يمكن القول بأن تشريعات هذا الدين الحنيف تستند في منبعها أو في مآلها إلى قاعدة أو أخرى من قواعد الأخلاق، ودليل ذلك قوله تعالى: {اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا»، وأحاديث أخرى تدلنا دلالة قاطعة على تجذر «البعد الخلقي» وراء كل تشريع من تشريعات الإسلام: سواء تعلق هذا التشريع بالعبادات أو المعاملات أو غيرهما.
واختتم شيخ الأزهر، الحلقة السادسة بأن الأعجب من كل ذلك ما يلاحظ من أن اشتباك البعد الخلقي بالبعد التشريعي في الإسلام لم يتوقف عند حدود المعاملات الإنسانية فقط، بل تعداه إلى اشتباك خلقي مماثل فيما يتعلق بمعاملة العجماوات والكائنات الضعيفة، فقد صح أن رجلا غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر بسبب رحمة حملته على أن يسقي «كلبا» كاد يموت من شدة العطش، وأن امرأة دخلت «النار» بسبب «قطة» أليفة حبستها حتى ماتت بسبب شدة الجوع والعطش، كما صحت أحاديث أخرى تلفت أنظار المتأمل إلى فلسفة هذا الدين الإنساني العظيم في تعظيم قيم الأخلاق وفضائلها، وأنها تمثل «الأصل» الذي ترتبط به تشريعات هذا الدين ارتباط الفروع بالأصل، ومعلوم بداهة أنه إذا ثبت أصل الأخلاق ثبت ما تفرع عليه من ثواب في العبادات والمعاملات، وإذا تآكل أصل الأخلاق أو تلاشى، سقطت الفروع وجفت الثمار.