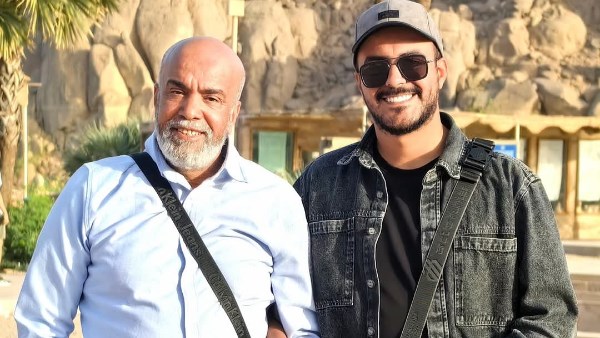قبل عام تقريبا من إجراء هذا اللقاء، كانت قد جمعتنا مكالمة هاتفية في أعقاب جائحة كورونا، تحدثنا فيها عن بعض الهموم، التي يعيشها جيل أصحاب المعاشات الخارجين من الخدمة بالطيران، بعدها انقطع تواصلنا المباشر، وبقيت فقط المتابعة من بعيد لما يُدونه عبر حسابه الشخصي "فيسبوك"؛ لتجبرنا ذاكرة كاميرته الخاصة التي جذبتنا لعدة أشهر بصورٍ يشاركها لنفسه رفقة رؤساء مصر السابقين وبعض القادة على متن الطائرة، إلى العودة مجددًا اليوم، لإتمام اللقاء دون أن نعرف شيئًا عنه سوى أنه مُضيف جوي سابق بالناقل الوطني مصر للطيران، ربما عاصر فترات تاريخية تستحق السرد.
فلاش باك قبل اللقاء
حددنا الموعد للقاء دون إعداد أجندة واضحة للحوار، فقط المخطط أنها ستكون مجرد جلسة فضفاضة -حتمًا سنخرج منها ببعض اللحظات الخاصة- التي تستحق السرد الصحفي، عن هؤلاء الزعماء الذي ظهر بجانبهم في صوره التذكارية على متن الطائرة – (عبدالناصر، والسادات، ومبارك ).
بمجرد وصولنا باب شقته الكائنة بحي مصر الجديدة؛ كانت بشائر الاستقبال تنُم عن رجل نبيل عاش في زمنٍ أرستقراطي.
ترحاب ابتسامته الهادئة مضافٌ إليها جلسته الوقورة بجوار زوجته؛ وسط لمسة الأنتيكات المختارة بعناية حول الأثاث، تحكي جميعها قصة مُضيف جوي راقٍ شهد على عصر "المودموزيلات"؛ عصر تقديم مشروب الشامبين الفاخر وهدايا البورسلين على الطائرات؛ عصر حيث كان ركاب طائرة الخطوط الجوية المصرية من البكوات وكبار الساسة ورجال الأعمال، زمن التباهي والاكتفاء باصطحاب القبعة والنضارة السوداء على الـ HAT RACK بالطائرة.

جلسنا في حضرته لعدة دقائق، وإذ به يتساءل بابتسامة خافتة؛ "ما الذي ذكرنا به الآن!".. فأجبت دون تردد؛ أن الشتاء يلزمه حديثا دافئا، واستحضارا لما يستحق من ذكريات أن تسرد؛ أخبرته أني وأبناء جيلي من المهتمين بتاريخ الطيران المدني المصري تغيب عنا فترات زمنية تستحق أن تخرج للعلن لنتباهى بما صنعوا، فقال إذن من أين نبدأ!.. هل فترة الرئاسة أم بداية العمل؛ هنا توقفت للحظة وتساءلت "عفوًا.. أي فترة رئاسة؟".. ليرد " عملت مُضيفًا جويًا على طائرة رئاسة الجمهورية لمدة 20 عامًا ".
صمت ثم انتباه أمسكت به اللقاء؛ "20 عاما !! ".. منها بدأنا الحوار مع مضيف طائرة رئاسة الجمهورية الجوي سابقًا كابتن أحمد حلمي.
أُبَّهَة الستينات.. وتحالف شركات الطيران
البداية كانت مع مطلع الستينيات بعد تخرجه مباشرة في كلية الألسن في عمر21 عامًا، حينها كان الطيران المصري يعيش زمن الجمهورية العربية المتحدة، وشركة مصر للطيران تم توحيدها مع مؤسسة الخطوط الجوية السورية تحت لواء عرف باسم "شركة الطيران العربية المتحدة "، كان الطيران المدني مفهومه العالمي لم يكن تجاريا أو اقتصاديا بالمعني المعروف الآن، ولكن كانت كل شركة طيران هي قائمة بهدف أن تكون دعاية للدولة؛ فتحمل علمها وتجوب به العالم؛ كانت الدولة نفسها ملزمة بتحمل أي خسارة تقع على عاتق ناقلها الوطني، باعتبار أنها كانت تفتح خطوطا جوية لمجرد أن تخدم أهدافا سياسية أو علاقات دولية، كانت تفتحها دون النظر للجدوى الاقتصادية أو حساب المكسب والخسارة، كان الطيران كُليًا أداة من أدوات الدولة السياسية تطوعها كيفما تشاء ضمن علاقتها الدبلوماسية.
في تلك الفترة تحملت مصر للطيران " طيران العربية المتحدة" حينها؛ فاتورة خسارة تشغيل خطوط أفريقية فرضتها العلاقات الدبلوماسية تجاه القارة السمراء، وتحملت أيضا خسارة تشغيل الخط الأشهر "تشيكوسلوفاكيا" من أجل صفقة الأسلحة الروسية في أعقاب هزيمة حرب 1967 ( النكسة )؛ تحملت عبء تشغيل هذا الخط، وكانت الرحلة تقلع بـ راكبين فقط أو ثلاثة ركاب على الأكثر، أضف إلى هذا رحلات الطيران التي استمر تشغيلها يوميًا إلى صنعاء والحديدة، لنقل جنودنا والضباط لقضاء أوقات الراحة المصرحة لهم في فترة حرب اليمن.

في الستينيات، - الفترة التي شهدها "حلمي" - كان غالبية شركات الطيران تسمي نفسها وفقا لموقعها الجغرافي، كانت الوحدة سمة هذه الفترة عالميًا ليست مصر وسوريا وحدهما، بل كانت كل مجموعة دول تتحد في شركة واحدة تحت لواء علم واسم واحد، مثلما كان "طيران العربية المتحدة " في المنطقة، كانت مجموعة الدول الاسكندنافية في أوروبا موحدة في شركة اسمها "ساس"، وفي أفريقيا؛ كانت مجموعة دول شرق أفريقيا تجمعهم شركة واحدة أيضًا ضمن تحالفهم السياسي.
كان مناخ الستينيات في مصر عامة وقطاع الطيران المدني بصفة خاصة، مليئا بالأحداث؛ كلما نقبنا وراء هذه الفترة من عمر الوطن كُشفت كواليس وحكايات راقية، سنوات كان مطلعها زهو وتوهج، لكن لحقته كبوة.. مطلع الستينات كانت الثقافة والرقي تملأن الأفق، الشوارع بلا زحام وبلا تحرش، النساء تسير بموديلات الفساتين الأنثوية الأنيقة، السينما في قمة مجدها، كانت مصانع النصر تنتج تليفزيونات مصر وحافلاتها؛ كانت الأيام بسيطة والأحلام طامحة، كان طاقم الطائرة المصرية يستقل الترام أو التاكسي إذا تعثر إحضاره من منزله بالحافلة، كانت أكبر أمنية للمضيف الجوي ( أحمد حلمي) وزميله من رحلتهما إلى اليابان التي تستمر لعدة أشهر هو شراء تليفزيون حديث، كانا يقتطعان ثمنه من بدل السفر، ليكون فوزهما به هو "خبطة العمر"؛ حسبما قال -.
ويتابع: "كان ركاب الطائرة من نوعية خاصة، فئة الطبقة الأرستقراطية، التي يتم استقبالها على الدرجة الأولى بمشروب الشامبين الفاخر وكوكتيلاته العتيقة، التي كانت تدخل طريقة تحضيره ضمن برامج تدريب الضيافة الجوية المقررة حينها؛ يقدم إلى جانبه مزيج من العصائر بأنواعه المختلفة، كانت الخدمة على الطائرات تقدم في أرقى صورها، كنا نتبارى لإظهار أناقة مصر أمام الراكب المحلي قبل الأجنبي، ذاك الراكب المكتفي باصطحاب حقيبة أوراقه الخاصة وشمسية أو قبعة يضعها على HAT RACK الطائرة، كان اختيار المضيف/ المضيفة الجوي، تحكمه أولا المعايير الثقافية والعلمية لذا كنا متفردين".
حرب اليمن ونقل الضباط بالإجازات
ظل وهج الطيران المدني أنيقًا، حتى جاءت ثورة اليمن عام 1962، وكانت البداية التي سحبت مصر إلى نفق مظلم بمشاركتها في الحرب التي دارت بين الموالين للمملكة المتوكلية وبين الفصائل الموالية للجمهورية العربية اليمنية، تذكرها - "حلمي " – بتنهيدة أخذته إلى تلك الأيام التي عاشها وزملاءه كأنها حدثت بالأمس. ويحكي " كانت مصر للطيران تشغل رحلة إلى مدينتي صنعاء والحديدة بشكل يومي، تقلع من القاهرة عند منتصف الليل، في تمام الثانية عشر صباحًا، لنقل جنودنا والضباط لقضاء عطلاتهم وأوقات الراحة المصرح لهم بها في فترة الحرب".

"كانت السعادة والفرحة الكبرى بالنسبة لنا، عندما كانت تهبط الطائرة المصرية في اليمن ونلتقي بجنودنا وضباطنا يهرولون مسرعين باتجاهنا في سعادة من الاشتياق للعودة إلى الأهل والوطن.. كُنا ننسى من لقاء فرحتهم مشقة كواليس هذه الرحلات وما يحيط بنا كطاقم طائرة". - هكذا وصف -
ويسترسل، قائلا: "في رحلة صنعاء حينها، لم يكن هناك أي فنادق في اليمن؛ كان طاقم الطائرة المصرية يقيم في قصر الإمام محمد البدر – ( أخر الملوك اليمنية الذي أطاحته الثورة ) - خلال فترة الراحة بعد رحلة كانت تستغرق نحو 5 إلى 6 ساعات، كان القصر الملكي بناياته مليئة بالسلالم المتدرجة شديدة الانحدار إلى الأسفل ذات سقف منخفض، كانت رحلة الوصول إلى الغرف الرئيسية والصالات الداخلية، تشبه السير أسفل نفق مظلم؛ صُمم هكذا خصيصًا حتى يسهل اصطياد الأعداء، ممن حاولوا التسلل إلى الداخل".
"وفي مدينة الحديدة، الأمر لم يختلف كثيرًا بالنسبة لإقامتنا بصنعاء؛ كان هناك بيت مكون من طابقين لصاحبه، ويدعى ( عم سُكر )؛ كان منزله ملجأنا الآمن لقضاء وقت الراحة من رحلتنا .. كان هو مدير اللوكندة وحمال الحقائب ومسئول خدمة الغرف؛ لم يكن هناك أحدًا غيرنا وهو برفقتنا .. كان هو كل حاجة !!".
ويذكر حلاوة استقباله بابتسامة، قائلا" كان ترحاب استقبال عم سُكر لنا، بكلمة ( ياهلا.. ياهلا بنسور الجو ) يُنسينا مرارة الإقامة في لوكندته، حتى أنه كان يُنسينا فترات انقطاع المياه الدائمة وتضليله لنا، بمد غرفنا بمياه الخزانات المستخدمة في الاغتسال من قبل.. هكذا عشنا فترة حرب اليمن".
هزيمة 1967.. سنوات ما بعد النكسة
لم تكد مصر تفيق من خسائرها الجمة، التي تكبدتها في حرب اليمن، حتى جاءت حرب 1967، لتمزق ما تبقى من معدات وعتاد، كان للناقل الوطني ( مصر للطيران ) نصيبه من هذه الخسائر، حيث تأثر مخزون قطع غيار الطائرات الغربية بالشركة، لعدم توافر العملة الصعبة، وتعثرت صفقة طائرات كان قد تم الاتفاق عليها مع شركة بوينج العالمية أيضا لظروف التمويل وأيضا تأثر تدريب الطيارين.
"في فترة النكسة، كان يونيفورم الطواقم الجوية دون المستوى، كنا ندخر من رواتبنا من أجل تفصيل يونيفورم يليق بطواقم الرحلات المصرية، كنا ننتظر رحلات تايلاند لإعداد يونيفورم جديد، حينها انقطعت الحوافز أيضًا والمميزات وانقطع بدل السفر التي كنا نحصل عليه في الرحلات الخارجية، واكتفت الشركة بصرف بدل وجبات فقط، حتى في خط طوكيو الذي كنا نغيب فيه لمدة ثلاثة أشهر لم نكن نحصل حينها على أي بدل، فقط كنا نحصل على جنيه ونصف استرليني عن وجبة الغداء ومثلهم لوجبة العشاء، وجنيه استرليني عن وجبة الإفطار، ونصف جنيه استرليني مصروفا".

ويستكمل "بعد الحرب تعرضت مصر للطيران، لهزة كبيرة إسوة بجميع كيانات ومؤسسات الدولة التي أصابتها خيبة النكسة، أصبحنا بعد ما كنا نهدي ركاب الدرجة الأولى على الطائرات هدايا من البورسلين أو الكريستال أو أعمال محمود مختار، وصل بنا الحال إلى تقديم فوطة للراكب مطبوع عليها رأس نفرتيتي أو توت عنخ آمون، كان الراكب الذي يفتح الهدية ويجدها هكذا، يسخدمها في تنيظف حذاؤه ويلقيها في وجوهنا كإهانة؛ أصبحت زجاجات المشروبات الغازية والكؤس الفاخرة غير متوفرة على الطائرات، بعدما أغلقت مصانع ياسين التي كانت انتاجها من رمال سيناء البيضاء، أصبحنا نستخدم زجاجات وكؤس رديئة كانت تصنع في منطقة القولالي".
تأشيرة مصرية وتسلط روسي
"بعد نكسة 67، أصدرت الدولة قرار بفرض التأشيرة ( ط.ب) من أجل توفير العملة الصعبة، وتعني ( طيران وبواخر مصرية )، كان هذا القرار بموجبه يمنع أي مصري من السفر على أي شركة أجنبية سواء طيران أو بواخر بحرية، بهدف توفير موارد لتسليح الجيش"، ويتابع "كنت حينها رئيس طاقم ضيافة جوية، فكانت الطواقم الجوية في رحلاتها الخارجية يتم تسكينها في "بنسيون متوسط الحال" بدلا من الفنادق، وكان يتم حجز غرفة واحدة لكل فردين يتشاركاها معها وهو المخالف لمعايير الطيران العالمية لضمان راحة طاقم الطائرة، ولكن تكاتفنا جميعا وتحملناها حتى مرت ".
ويذكر أحمد حلمي، العام الذي تلى النكسة، مطلع 1968، وكواليس وصول أول طائرة بوينج لمصر للطيران من أمريكا، يذكر كيف تم استقبالها في مطار القاهرة بالموسيقات العسكرية وتم تجهيز ريسبشن خاص لها، ويصف، قائلا: "كان يوم وصولها محل افتخار وتباهي، حينها كان أسطول مصر للطيران يقارب 15 طائرة فقط، تم اتخاذ قرار بتخصيص هذه الطائرة الجديدة لتشغليها على رحلة لندن، وكان الخط الاكبر في تاريخ الشركة حينها؛ ليأتي بعدها احتياج مصر إلى روسيا من أجل صفقة الأسلحة في أعقاب النكسة، حينها فرض الطيران الروسي نفسه على خطوط التشغيل الرئيسية لـمصر للطيران، وضموا إلى أسطول الشركة طائرات حربية عائدة من الحرب العالمية الثانية، تم تحويلها إلى طائرات ركاب مدنية، للعمل على خطوط مصر للطيران كنوع من الدعايا والسيطرة لروسيا، ففرضوا علينا تشغيل طائراتهم وعددهم 7 طائرات على أكبر خطوطنا، كان منها خطي ( باريس ولندن)، وفرضوا على مصر تجهيز وتهيئة هذه الطائرات من الداخل بنفس تجهيز طائرة البوينج B707 الجديدة، ورغم ذلك لم تفلح التجهيزات في شيء، فكانت الطائرات الروسية سيئة السمعة في المجال.

ويحكي:" أذكر أنه في إحدى الرحلات في مطار روما حينما رأى الركاب الطائرة، امتنعوا عن الصعود ورفضوا بشدة هذه الرحلة وعادوا، فكان هناك طائرة معروفه في المجال باسم الكفن الطائر كانت تسمى TU154، لأنها في حالات الهبوط كان تسقط دون معرفة الأسباب"، واستشهد بالواقعة الشهيرة لسقوط طائرة التدريب الروسية في منطقة الهايكستب، في أول السبعينات، الذي راح ضحيتها المدربين الروس والمتدربين المصريين اللذين كانوا على متنها، ليأتي بعدها قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعودة هذه الطائرات إلى روسيا، فيرفض الروس الاستجابة للقرار واستلام الطائرات، فيأمر السادات بأن تترك في العراء على أرض المهبط بمطار القاهرة، ويتم فتح سلالمها حتى تلتهمها القطط والفئران، وظلوا هكذا لمدة 5 أشهر يقاومون تنفيذ القرار حتى تراجعوا حينما رأوا طائراتهم تتآكل على المهبط بعد تمسك السادات بموقفه، فقرروا سحبها وأعادوها إلى الاتحاد السوفيتي، بعد عامين من فرضهم على الخطوط المصرية التي خسرت الكثير مقابل هذا التشغيل بعد تجنيب طائراتنا مقابل فسح المجال لطائرات روسيا؛ - هذا كان أول موقف يتعلق بالطيران المدني يشهد "حلمي" مع الرئيس الراحل السادات قبل انتقاله إلى طاقمه بالطائرة الرئاسية -