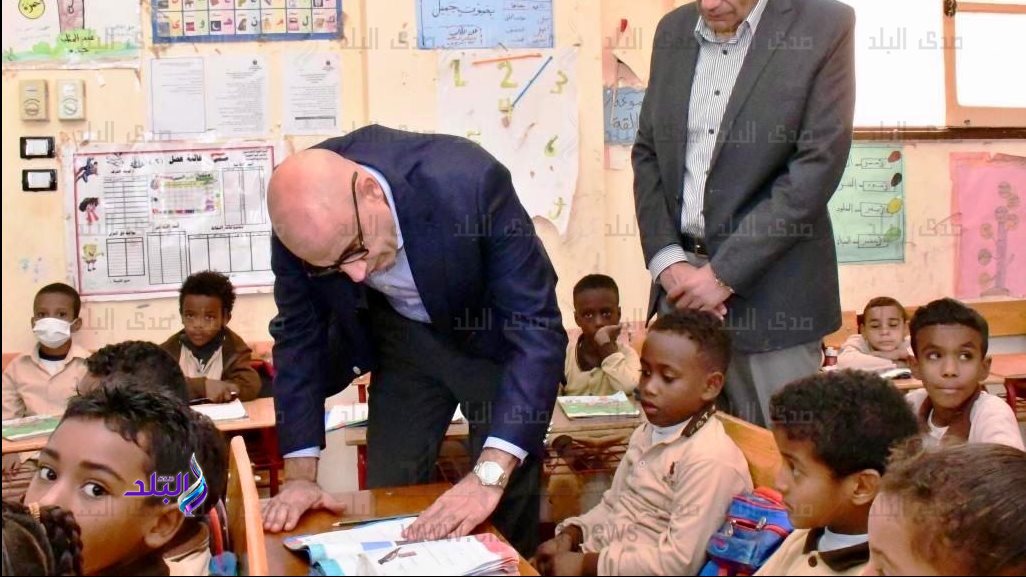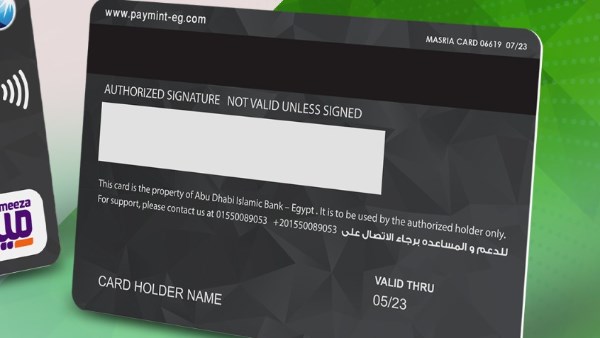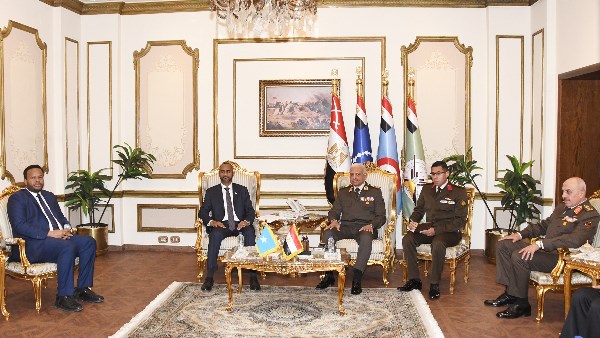كاسر هادر، ثائر فائر، هو أحد سنن الكون وطريق قد يؤدي للجنون، نصح الحكماء بالابتعاد عنه، وحاول العقلاء الهروب منه، ولكننا بشر ولسنا ذرات مدفونة في قلب حجر، فكيف لنا المُضي بعيداً عنه، إنه قَدر، وكأس يتجرعه الناس ولكن بقَدِر فهو تنفيس لإحساس قد يمر دون مساس أو ربما يصبح وابلاً من الرصاص.
إنه الغضب كاشف المعادن النفسية، والاختبار الذي تسقط أمامه الأقنعة التمثيلية، فادعي ما شئت من الفضيلة ولكن الغضب طريق ممهد للرذيلة، وأولها القتل باسم الحقيقة، فالغضب هو إحدى طرق الاغتيال مادياً أو معنوياً ليس فرقاً مهماً، فكلاهما موتاً سخياً.
ولن أنكر فضل الغضب فهو الشرارة الأولى للتغيير وأول مفاتيح التأثير، هو داء لكن مرارته كالدواء يشبه الحزن الذي نبغضه ولكننا مدينين بالفضل له فهو محفز الإبداع الأول، فلولا الحزن ما ابدع الشعراء وما وصلت إلينا أجمل الروايات وما تعلمنا من أتعس اللحظات قيمة أجملها ولا أخذنا العبرة من أقسي العبرات.
نستقبل لحظاتنا الأولى في الحياة وملامحنا يكسوها غضب عارم وصراخ هائم، لم نأتي للحياة فرحين ولا راضيين بل وجدنا فيها غاضبين، بحناجرنا الضعيفة نبذل أقصى جهد لنعلن أننا مأزومين ولا نريد أن نفارق رحم أمهاتنا وتلك أول دروس الحياة التي نتعلم فيها الأنين والحنين.
نمارس الغضب كعادة بالرغم أنها لم تمنحنا يوماً السعادة ولكنه سيظل أحد علامات الاستفهام الفلسفية، التي لا نعلم هل من المستحسن أن ندركه أم المستهدف أن نتركه!
ولكن إذا وصل القِدر لدرجة الغليان دون تنفيث فذلك سيكون بمثابة ترفيس نفسي، عدم التعبير عنه سينعكس بالقصور العقلي والاعتلال الجسدي.
وإذا كان الغضب شر لابد منه، فكيف يمكن اتقاء شره، فهل ذلك بتجنب أسبابه وعدم الانسياق خلف ضجيجه قد يبدو هذا أمرًا مستحيل، فتعددت الأسباب والغضب واحد، والغضب مثل روما كل الطرق تؤدي إليه وكالجلجثة لا سبيل بعد الذهاب للعودة منه.
فهو طاقة مدمرة ولكن لها أيضاً قدرة مُحررة، تكسب منها أعداء وتخسر بها أصدقاء وأولهم نفسك، هل حيرتك كلماتي! وماذا أفعل إذا كانت تلك الوساوس تدور في مخيلاتي، وما أسطر تلك الحروف إلا لنتشارك بعض الهموم ونقتسم الظنون لعلنا يا عزيزي نخلع نعلي الحياة ونصل لتلك البقعة التي تصلي فيها أرواحنا احتفاءً بالسلام وننسى كل ما مرّ بنا على الأرض من كلام.
لا أدعي الحكمة ولا أرتدي ثوب الفضيلة لأنهاك عن صفة من رحم الطبيعة، وفي ذات الصلة هل رأيت غضب الطبيعة! وجنون أمنا الأرض الحكيمة! وتمتمات الكون الصاخبة والسماوات وهي كئيبة!
ولن أخص الزلزال العنيف الذي هزّ قلوب البشرية والأراضي السورية والتركية بالحديث، ولكن لأنه لازال حديث سنستشهد به ونحن نكمل الحديث، تلك الهزة التي أصابت الأراضي التركية والسورية فجعلتها كالأثر بعد عين، يا الله في طرفة عقل ونبضة قلب انقلبت الأرض رأسًا على عقب، ثواني قليلة جعلت جحيم الأفكار واقعاً ملموساً، مأساة بدأت في فجر يوماً ما ولكن تداعياتها قد تستمر في حياة أحدهم حتى غروب عمره في وقت ما، قاسية هي الحياة، بغيضة هي الاختبارات ولاشك أنها رحمات ولا يقبل عقلي من فسرها أنها تخليص حسابات، فهو الرحمن الذي ما يبتغي لنا إلا رفع الدرجات أو ثِقل في ميزان الحسنات، لكن إذا صبرنا واحتسبنا أي إذا لم نقابل الغضب بالغضب ولكن أليس هذا في ذاته مدعاة للغضب!
أشعر بالارتباك وتضنيني الحيرة التي تهز شراع بأسي فتهدد سفينة سلامي النفسي، أرقام الكوارث الطبيعية مفجعة ففي العشرين سنة الماضية إليك بعض الأرقام المرعبة التي خلفتها الزلازل وحدها دون غيرها، الصين في عام ٢٠٠٨ قرابة ٨٨ ألف قتيل وباكستان ٢٠٠٦ ما تجاوز ٧٣ ألف والهند ٢٠٠١ وصل القتلى إلى ١٤ ألف، أما زلزال إيران منذ بضع سنوات قارب ٣٢ ألف قتيل أيضاً.
أما هذا الضيف الثقيل الأخير فحتى كتابة تلك السطور وصل عدد الضحايا لما يجاوز الخمس والثلاثين ألفاً، بالطبع العدد قابل للزيادة مع تراجع الأمل والفرص في العثور على ناجيين تحت الأنقاض، ودخول المعدات الثقيلة لرفع آثار الزلزال سريعاً بعدما فرضت رائحة الموت عبقها لتعلو فوق نسائم الحياة، فبالرغم من برودة الجو الشديدة والتي حالت دون تحلل الجثث بصورة سريعة إلا أنها لن تحول دون قوانين الطبيعة الأكيدة أننا منها وإليها نعود، فالجراثيم والأوبئة المتوقعة ما هي إلا محفزات لرفع الدمار بوتيرة متسارعة دون الالتفات لما تبقى من الرفات.
سكت صوت الأنين، ولم يبق إلا الواقع الحزين، سيمر الأمر كما مرّت الكوارث السابقة، ولن نراهن على ذاكرتنا في المفاجآت اللاحقة، لكن هناك تلك العلامة في الروح التي تسكت لأنها أصبحت عاجزة عن البوح، سنتذكر ببراعة أن غضب الطبيعة فتاك دون هوادة، فالغضب مساوئه تجُب محاسنه، ولو اعتبرنا أن هذا الغضب كشف فساد عشرات المقاولين الفاسدين في تركيا، كان من الممكن أن نصل لذات النتيجة لو كان هناك حفنة من أصحاب الضمير.
لا راد لقضاء الله، ولا ألوم الطبيعة فقط هي محاولة خاوية لفهم مجريات الكون لتصل في نهايتها للهاوية، ولكن عراك الأفكار هو سمة وجدانية قادتنى لافتراض آخر، فماذا لو كان الغضب برئ وما حدث لم يكن إلا حركة أرضية عادية وهي التي يصفها العلماء بالتكتونية، ولم تدري تلك الصفائح وهي تتمخض بما ستكشفه من فضائح!
متمثلة في أوجه المحنة اليائسة التى كشفت عن عوار نفوس بائسة، حماقة البعض ممن يتعلل بالسياسية للتنظير على أولوية المساعدات الإنسانية، وبلاهة بعض من يتندر أنه لم يشعر بالزلزال، ووقاحة من تأله ليبرر ما حدث بالعقاب وإذا سألت عن ذنب الأطفال إذا كان الأمر انتقامياً يفاجئك ببجاحة بإجابة بها الكثير من التألي على الله.
إنها حكمة الله الذي ورثنا أرضه ولم نصون عهده، انتصرنا للغضب على حساب الرحمة، أسرفنا في الذاتية وتناسينا أننا نسيجاً من البشرية، افرطنا في ادعاء المعرفة حتى ظننا أننا نملك مفاتيح العلم الزائفة، لم نتعاطى الحياة بالتوازن المطلوب والخلق المرغوب، بالغنا في البحث عن المبررات حتى أصبح من المقبول أن نصدق فتوى الزلزال المصنوع.
الله عادل، لم يخلقنا ليظلمنا نحن من ظلمنا أنفسنا عندما تسببت تصرفات الإنسان الغير مسؤولة في الكثير من المفاجآت الغير محسوبة مثل التغيرات المناخية التي سببت آلاف الوفيات في العام المنصرم وحده.
الغضب عاصِف وأسوء مغباته البحث عن حامل يلقي عليه الإنسان أزماته، لذا ربما إذا توازنت البشرية داخلياً قد تتزن الطبيعة خارجياً.
ولن يمنع ذلك عن كليهما ممارسة الغضب، ولكن بحكمة العبد المستسلم للمقاومة وليس المقاوم بالاستسلام، فالغضب دون حكمة كالعربة دون مكابح، اعقد مع نفسك اتفاقية سلام بأن ليس على الأرض ما يستحق أن يسحب من روحك نسمات السلام، وسيطر على غضبك ولا تجعله هو المسيطر عليك، كفانا الله وإياكم والطبيعة شر الغضب، وتغمد ضحاياه في كل مكان برحماته ومصابيه بستره وشفائه.