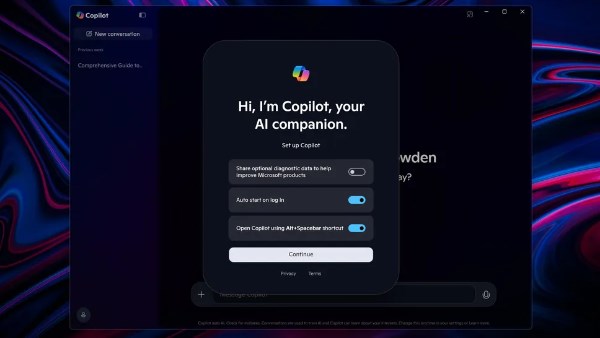كثيرون لا يعلمون أن تقدُّم الدول ليس بأجهزتها فقط، وإنما بقوة شعوبها وصلابتهم ووقوفهم لنمائها باستمرار، وبنظرةٍ سريعةٍ على جميع الدول التى تقدَّمت فى العقود القريبة؛ نجد دولًا مثل الصين واليابان والنمور الآسيوية، الشريك الأول فى تقدُّمها هم أنفسهم شعوبها قبل مؤسساتها وأجهزتها، ونحن نعلم أننا بشرٌ خطْاَؤون، لكن الخطأ أيضًا يكون بحجم الإنسان ومركزه.
هناك مَنْ يعتقد أننا كنا فى نعيمٍ عندما كان الجنيه المصرى بقروشٍ، ولم نكن حينها ممَّن لجأ للاستدانة من قبل، لكن هذا ليس حقيقيًا، فالجنيه المصرى أيام الاحتلال كان أقوى، إلا أن حنين البعض للعودة إلى هذا الماضى مغامرةٌ لا يُحمد عقباها.. إذن لماذا؟!!
نعم؛ الجنيه المصرى كان أقوى أيام الاحتلال؛ لأنه ارتبط بالجنيه الأسترلينى، حيث إن مصر كانت تابعةً لبريطانيا العُظمى، فبالتالى الجنيه المصرى لم يكن مُعبِّرًا عن وضع مصر الاقتصادى، والذين يتمنون العودة لمثل هذه الأيام، أوضِّح لهم أن الشعب المصرى، فى هذه الفترة، كان 40% منهم (حُفاة)؛ بمعنى أن الفقر كان سائدًا ومُسيطرًا، وأمنية العودة لهذه الفترة مجازفةٌ كبيرةٌ؛ لأنهم ممكن أن يكونوا من الفقراء بالمعنى الحقيقى لكلمة الفقر، فالثراء فى ذلك الوقت كان لشريحةٍ صغيرةٍ؛ لأن خَير مصر لم يكن لأهلها، بل كان لبريطانيا المُستعْمِرة للبلاد.
وخرج الاستعمار بثورة 1952، وكانت بريطانيا فى ذلك (مُنْهكة) بسبب الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى تحويل الكثير من خيرات مصر إليها دون أى مقابلٍ، وبصدور قانون الإصلاح الزراعى الذى ينص على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، تحوَّل الفلاح إلى مالكٍ الأرض فى غمضة عين ودون أى عناءٍ منه، وتطوَّر الحال للبناء على الأرض الخٍصبة وتجريفها، وانقلب حال الفلاح من مواطنٍ مُنتجٍ إلى مُستهلكٍ فقط، فاعتمد على رغيف العيش المُدعَّم، بعد أن كان يخبز فى بيته الريفى، رغم كون شراء العيش من قِبل الفلاح الذى يُجيد الزراعة فى الماضى (عيب)، والآن أصبح يشترى العيش له وللمواشى التى يمتلكها فى آنٍ واحد، وباتت طبقة الفلاحين أولى الطبقات التى تحوَّلت من مُنتجة إلى مُستهلكة.
فكرة التعليم للجميع، هى فكرة ومجهودٌ مُقدَّران من الدولة لا يُمكن لأحدٍ إنكار ذلك، ولكنها، فى الوقت نفسه، سلاحٌ ذو حدين، فالتعليم (فرض)، لكن كيفية ترتيب هذه المنظومة بتلك الطريقة هى الأهم من التعليم ذاته، إذ كانت فكرة التعليم للجميع مجرَّد سُلّمة واحدة من تدَّرجٍ هرمىٍّ كبير، فالجميع كانت بُغيتهم حينها الدراسة لأجل الجلوس على مكاتب الدولة وكراسيها؛ ليتحوَّل الأمر وهؤلاء المتعلمون إلى عبءٍ آخر يُضاف إلى غيره من الأعباء التى أثقلت كاهلها، لتظهر سمة شىءٍ جديد اسمه البطالة المُقنعة.
وبالفعل لم تستطع الدولة فى ذلك الوقت بناء باقى الهرم التعليمى؛ من التعليم المهنى والاهتمام به، واعتباره جزءًا لا يتجزَّأ من التعليم عامةً، وأصبح لا فرق بين مُتعلِّمٍ جامعىٍّ و فنىٍّ إلا بالعمل، حيث أُطُلق على هذه الفترة "عصر الاقتصاد الذهبى"، وأسهمت تأميمات الدولة التى اتخذت قرارها فى وقتٍ حَرج، فى السيطرة الكاملة على الاقتصاد المصرى والتخلِّى عن القطاع الخاص، فكانت النتيجة سريعة ومُبهرة، وارتفع دخل المواطن المصرى، ولأن نتيجتها كانت سريعة كانت نهايتها أيضًا أسرع، فمع زيادة الدخل بدأت عمليات شراء السلع الاستهلاكية فى الازدياد، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات، ومع الإنفاق الحكومى الكبير، حدث عجزٌ فى ميزان المدفوعات، وبالتالى ظهرت سيئة الاستدانة من جديد.
وبدت المرحلة أكثر سوادًا بعد نكسة 1967، لينحدر الاقتصاد والجنيه المصرى؛ بسبب الركود القاتل، وتراجع الإنتاج الزراعى، وكانت تلك الأمور سببًا رئيسًا وأساسيًا فى التدهور الاقتصادى، إذ كثرت الديون (قصيرة الأجل) لسد الحاجة.
وعلى الرغم من كل تلك العوامل الكبيسة التى عانتها الدولة، لم ينحدر الجنيه المصرى أمام الدولار، بسبب انخفاض قيمة الدولار عالميًا، إضافةً إلى تثبيت سعر الصرف من البنك المركزى، بمعنى أن سعر الجنيه المصرى فى ذلك الوقت لم يُعبِّر عن الوضع الحقيقى للاقتصاد الوطنى، واستقر سعر الدولار عند 43 قرشًا فقط.. ثم جاء عصر الانفتاح وما أدراك ما الانفتاح، ففيه ظهر مواطنٌ مصرىٌّ من نوعٍ فريد لا يهتم غير بأرقامهِ فى البنوك، واختلط المجتمع، ولم نعلم مَنْ هو الجيد من السيئ، وزادت ديون مصر عام 1975 من 4,8 مليار دولار إلى 14,1 مليار دولار حتى سنة 1977، ووصلت عام 1981 إلى 14,3 مليار دولار، ليصل بذلك سعر الدولار 60 قرشًا، بسبب فتح باب الاستيراد على مصرعيه دون أى حساباتٍ للسوق، إلى أن بلغ سعر الدولار نهاية المطاف 70 قرشًا وقتئذ.
فى بداية الثمنينيات استمر عجز ميزان المدفوعات حتى وصل إلى 1,7 مليار دولار؛ ليصل إلى 2,5 مليار دولار عام 1986، فاضطرت الدولة للاستدانة مرةً أخرى، ليصل الدولار 93 قرشًا بنهاية عام 1985، وفى بداية عام 1986 انخفض سعر البترول 50%، مُتسبِّبًا فى كارثةٍ جديدة، وهى تراجع مُعدل التبادل التجارى، مما أثَّر على دخل قناة السويس، وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالدول المُعتمدة فى اقتصادها على موارد النفط بسبب تراجع سعره.
ووصلت المديونيات على الدولة عام 1990 إلى حد الإفلاس، وواصل الدولار رحلته التصاعدية إلى أن بلغ 1,5 جنيه مصرى، وبعد حرب الخليج، ونتيجةً لإعفاء مصر من نصف ديونها حتى وصل الدين العام الخارجى إلى أدنى انخفاضٍ له فى عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووصل سعر الدولار إلى 3,33، ليستمر ارتفاع الدولار إلى 6,50.
وفى عام 2011، وبعد أحداث يناير وصل الدولار إلى 7 جنيهات، ثم قفز بعد ثورة يونيو إلى 7,15 جنيه مصرى حتى وصل إلى 8,88 جنيه عام 2016، وفى نفس العام وافق صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضٍ يُقدَّر بنحو 12 مليارًا بشرط تعويم الجنيه ليرتفع الدولار إلى 13,5 جنيه.
مع ظهور فيروس كورونا انهارت معظم العملات العربية باستثناء دول الخليج بسبب احتياطى النقد الأجنبى لديها، وأيضًا سيطرة البنوك على سعر الصرف.. كما انهارت عُملة اليابان إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 24 عامًا، وكذا الدولار الأمريكى وغيره من العملات، وكل هذا يعنى أن الوضع فى بلادنا ليس استثناءً، لكنه دولىٌّ عالمىٌّ من الدرجة الأولى.. أيضًا ليست هذه أول مرة تتعرَّض فيها مصر لظروفٍ قاسية، والذين قرأوا التاريخ جيدًا يعرفون أن مصر تعرَّضت من قبل لمجاعةٍ أكل فيها المصريون القطط والكلاب، وكانوا من آكلى لحوم البشر فى العهد الفاطمى، وأطلقوا على تلك الفترة (الشدة المستنصرية)..
كلنا مسئولون عمَّا حدث.. والسؤال ماذا فعلنا من أجل الجنيه غير اعتمادنا على الدولة؟ وماذا لو اهتمت الدولة منذ عقود بالتعليم الفنى للقضاء على البطالة؟ ماذا لو كانت هناك دراسات من عقودٍ قبل الانفتاح وفتح باب الاستيراد على مصرعيه دون دراسةٍ للسوق المصرى؟ ماذا لو تم تعويم الجنيه المصرى منذ عقودٍ فى وقتٍ كانت الظروف الاقتصادية أفضل؟ ماذا لو لم تكن كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فى هذا التوقيت الذى حاربت وتُحارب فيه مصر من أجل البقاء، وواجهت الظروف الصعبة بالبناء والتعمير؟ ماذا لو ساعد كل ميسورى الحال المحتاجين بدلًا من التشدُّق والمُتاجرة بفقرهم؟ ماذا لو فكَّر كل مصرىٍّ فى عملٍ يُفيده أفضل من جلسات المقاهى التى كانت يومًا ما مكانًا لأصحاب المعاشات، واليوم انتشرت، وأصبح شعارها مقهى لكل مواطن؟
ماذا لو عملنا بشكلٍ جماعى للمساعدة؟
وأخيرًا.. ماذا لو علم المصرى أن صرخات البعض بسبب أن الدولة فتحت جراحًا قديمة لم يجرؤ أحدٌ على فتحها من قبل، فتحت جراحًا بدون مُخدِّرٍ، فكانت صرخات المواطن ولو عَلمَ أنها صرخات مثل صرخات المخاض المُبشِّرة بميلادٍ جديد؛ لتحوَّلت لضحكاتٍ وأفراحٍ تهز أرجاء المحروسة..
أتمنى أن أحيا ليومٍ أراهن فيه على أن تكون بلدى ساكنةً للصفوف الأولى من الدول الحاكمة للعالم، و هو أمرٌ ليس بعسيرٍ إذا اتفق عليه كل مصرىٍّ عشق بلده.. لا تيأس وتذكَّر ما قاله رجل الأعمال ناصف ساويرس: لا تخشوا من تعويم الجنيه، فأداؤه أفضل من الين اليابانى.