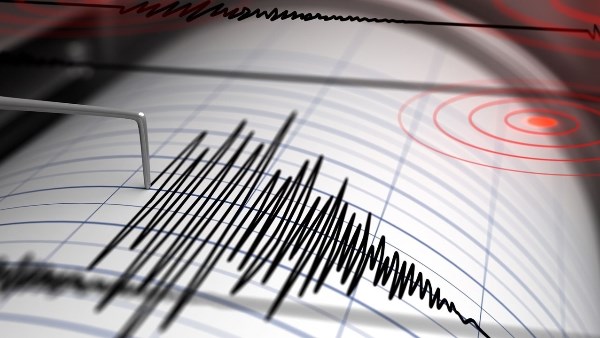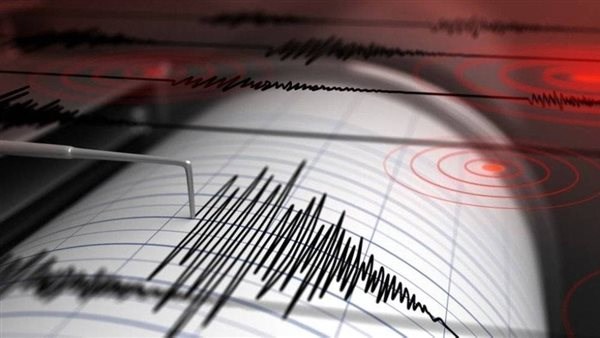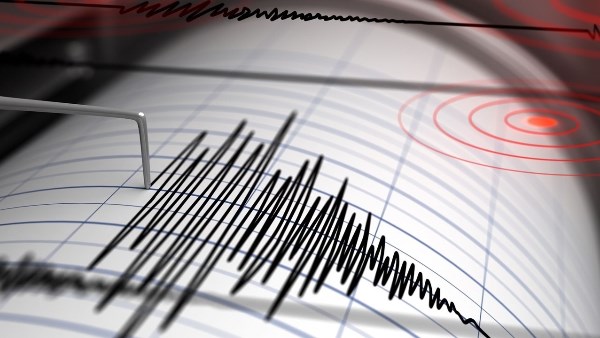كان المقهى يمثل لنا ذلك الملتقى الثقافي والسياسي والرياضي بل والديني، ولقد كان هناك مقاهٍ مشهورة بجلساتها الثقافية والسياسية، حيث يؤمها المثقفون ويحج إليها، بجانب التجار و"الصنايعية"، المتعلمون فيتسامرون عليها، ويقيمون حلقات نقاش ربما امتدت بالساعات، يدلي فيها الجميع بدلوه، فينقسمون إلى فريقين أو أكثر: يدافع كل فريق عن وجهة نظرة دفاعا مستميتا، وفي كثير من الأحايين لم يكن الفريقان أو الفرق المتحاورة يصلون إلى ما يمكن أن يوحدّهم على رأي واحد: ومتى كان ذلك ممكنا؟. خاصة في تلك القضايا التي كانت تتحمل أكثر من وجهة نظر، ويمكن النظر إليها من أكثر من زاوية، فقضايا النقاش، لم تكن قضايا علمية بحتة، تلك التي يفصل فيها العلم بالحس والتجريب، ولكنها غالبا ما كانت قضايا: اجتماعية وثقافية وسياسة بل ودينية، تلك التي هي قابلة للاختلاف وفيها دوما متسع لأكثر من رأي.
كان، إذًا، المقهى هو ملاذنا ليلا، يشهد اجتماعاتنا، ونتبادل فيه وجهات النظر، التي كانت تعكس قناعات كل منا، تلك التي استقاها مرة من البيئة التي نعيشها، ومن القراءات التي نقرأها، ومن التفكير العقلي الذي تتباين مستوياته وقدراته، ومن ثم لم يكن هناك من سبيل لردم فجوة الاختلاف ردما تاما، بل كان أقصى ما يمكن الوصول إليه هو التقريب أو التلفيق للتقريب بين وجهات النظر تلك المتباينة.
كنا في ريعان الشباب، كان ذلك في ثمانينيات القرن الماضي وأوائل تسعينياته، وكانت البيئة تستعر بالعديد من الاتجاهات والكثير من الأفكار، فكانت الجماعات الإسلامية تنشط بشكل كبير في مدينتي - مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية - وفي المقابل كان تيار مدني ينشط وإن لم يكن بحجم التيار الإسلامي الذي يسيطر على عقول القطاع الأكبر، كما كان الشأن في كل بقاع مصر، وكان من بين القضايا المنتشرة في تلك الأيام، ما زعمه أحد الزاعمين بأنه يعالج بالجن والعفاريت، وأنه استطاع أن يسخر له "2 بليون من هؤلاء الجن والعفاريت: الصغير منها والكبير"، وأن لديه القدرة على علاج كل الأمراض بما فيها السرطان وغيره من الأمراض المستعصية، وأنه يجري العمليات الجراحية للمريض وهو في غرفة والمريض في غرفة أخرى، وتكون نتيجتها صحيحة 100%، وانتشر خبر هذا الرجل في كل مكان بمصر، وبدأ الناس يؤمّون مقر إقامته يلتمسون الشفاء من الأمراض التي ألمت بهم، وعجز الطب عن معالجتها.
هذا الزعم لذلك الشخص احتل الوقت الأطول من حديث تلك جلسات النقاش على مقهى عم "طه" أحد أشهر مقاهي مدينتنا في ذلك الحين حيث كان يتقاسم هذه الشهرة مع ملاصقته مقهى "عطية" الذي كان يجلس عليه الموظفون بدرجة أكبر من غيرهم من فئات المجتمع، حاولت أن أسبر الغور للحصول على أسباب تفضيلنا لجلسة المقهى عن مركز شباب المدينة في ذلك الوقت؛ فتوقفت عند الحرية التي كان مسموحا بها بالنقاش في المقهى، حيث لا قيود على الحوار، إلا تلك التي تفرضها قواعد المجتمع والأصول المتبعة في البيئة، وليس هناك من يطالب بالالتزام بقواعد وتعليمات رئيس النادي أو الهيئة الإدارية، فلا وصاية من أحد، بالإضافة، وهذا في الحقيقة هو السبب الأهم، لتقديم المقهى لـ "الشيشة" التي كان يدخنها الغالبية من روادها في تلك الجلسات، كما كان البعد المكاني للنادي الذي تم بناؤه خارج المدينة القديمة في امتداد لها مع مجمع الخدمات المدنية وقسم الشرطة والمستشفى سببا إضافيا.
انشغل الناس بهذا الموضوع انشغالا كبيرا، فانقسموا، كما هي العادة، ما بين مصدق لهذا الزعم، وكانوا الأغلبية، فالإيمان بالجن والعفاريت جزء من الإيمان بالإسلام، وكان هناك فريق يرفض الرجل نفسه، ولكن أفراده لا يرفضون قدرة العفاريت والجان على الإتيان بمثل ذلك، فلهذا العالَم - عالم الجن والعفاريت- من القدرة ما ليس لعالم الإنس، وهناك قلة، كنتُ أحدهم، ترفض هذا الزعم شكلا ومضمونا، فهذه القلة وإن آمنت بوجود عالم الجن، لإيمانها بما أتى به القرآن الكريم، فهي تنكر كل الإنكار قدرته على شفاء أو مرض أو قدرته على التحكم في الإنسان.
الملفت في هذا الموضوع أن الغالبية الساحقة كانت ترفض أن تعود للأطباء أو حتى العلماء "في العلوم" للتعرف على رأيهم في هذا الموضوع، وهو أمر يتفق مع المنظومة الفكرية للمجتمع في هذه اللحظة في أوائل تسعينيات القرن الماضي، بل أزعم إلى الآن، فالرجل المدعي جاء في بادئ الأمر ليشفي المرضى من تلك الأمراض التي استعصت على علم الطب، هذا الذي تم اختياره بعناية من مُسَخّر هذه الجيوش التي لا تعد ولا تحصى من الجن والعفاريت، وهو بهذا قطع الخط على الأطباء، فلو كان لديهم علاج لتلك الأمراض ما احتار الناس وألغوا عقولهم واستسلموا لمثل هذه الأفكار والتمسوا عنده العلاج.
هذه الأفكار التي نرى لها مثيلا مطابقا تمام التطابق في القارة الأوروبية في العصور الوسطى، حيث كانت العفاريت والجان تلعب دورا في مخيلة وعقائد الناس، هذا الذي وصفه "وِل ديورانت" وصفا دقيقا في موسوعته الشهيرة "قصة الحضارة". والتي رأيت فيها مجتمعنا المصري المعاصر رأي العين وأنا اقرأ تلك الفترة في القارة الأوروبية، من إيمان بالخرافات، ومن جماعات دينية متشددة هي هي نفس الجماعات التي عندنا، فمن يتعرف على البيوريتانيين في تفاصيلهم الدقيقة في الملبس والمأكل والمشرب وتحريم لزينة الحياة الدنيا، وتحريم للفن من غناء وتمثيل وغيرهما ليرى لها مثيلا في بعض الجماعات الدينية عندنا، وأكثر من ذلك فإننا نرى في تلك الفترة، كما نرى عندنا، جشع أصحاب المال وسعيهم للمكسب بكل الوسائل مع عدم مراعاتهم لظروف الطبقة الكادحة من الشعب، ونشاهد انتشارا للرشوة وأساليب متعددة ومبتكرة للفساد الذي كان يضرب تلك البلدان، ويمكننا أن نشم الروائح الكريهة بسبب قذارة الشوارع التي يصفها الكاتب ببراعة شديدة مقززة.
وكان لابد أن يدلي الدين بدلوه فيما زعمه هذا الزاعم، فخرج علينا الشعراوي، وكان قد أصبح أكثر ثقة عند عوام الشعب المصري من شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، أما الجماعات الإسلامية فكانت ترفض الرجلين: الشعراوي وطنطاوي كليهما، فهما يمثلان لديها شيوخ السلطة، هذا الذي تغير بعد موت الشعراوي حيث أوصلوه لدرجة التقديس، فلم يعد مسموحا لأحد الاقتراب منه، وهو الذي كان هدفا دائما لسهامهم المسمومة المسنونة، خرج علينا الشعراوي مع الإعلامي طارق حبيب، على ما أتذكر، ليؤكد أن الإيمان بعالَم الجن والعفاريت لهو من أصول الإيمان في الإسلام، وأن لأبناء هذا العالم القدرة على التحول والتغير والتبدل، ولكن لكي تستمر الحياة بشكل "معقول" فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هناك تكافؤا في الفرص، فإذا كان لدى الجن أو العفريت أن ينتقل من حالة إلى حالة فإنه إذا وقعت عين الإنسان عليه في حالة معينة، وليكن مثلا حالة قط أو كلب، فإنه يُحْبَس فيها فلا يستطيع أن يتحول منها لحالة أخرى مادام يقع في حيز تعامل الإنسان معه.
وهو مَخرَج رأيناه بارعا لمخاطبة البسطاء، ولكنه لم يقدم دليلا ولا حجة ولا تفسيرا يقنع به العقول المتأملة، ولكن التخريج، على كل حال، كان واسعا فضفاضا يمكن أن يصلح، مع التأويل، ليتخذه كل متحاور في جلسات نقاش المقهى دليلا على صحة وجهة نظره، حيث إنه لم يحسم شيئا.
أما رأي الشعراوي في هذا الزاعم، فإنه اقترح أن يٌؤخَذ له شخصٌ مشلولٌ، فإن قام هذا الشخص من على كرسيّه، فالرجل ليس كذابا، وإلا فإنه مشعوذ، هذا الذي رأينا فيه نظرا عقليا سليما، فالشيخ الشعراوي يريد تجربة مادية دليلا على صدق المدعي من كذبه، وهذا ما ننادي به دوما، للتخلص من هؤلاء المدعين والذين يندرج زعمهم تحت ما يسمى البارسيكولوجي والذي لم يعترف به المجتمع العلمي حيث تم تصنيفه ضمن العلوم الزائفة، وهناك تجارب كثيرة قام بها العلماء في هذا المضمار قبل أن يتوصلوا لهذه النتيجة.