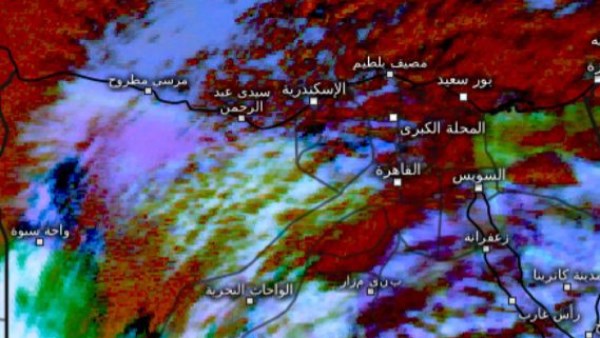في عام 2018 وقبل نحو عامين بالضبط من الآن، طرحت دويتشة فيله الألمانية، وهى الإذاعة الألمانية الدولية الموجهة للعالم، وعبر موقعها الالكتروني باللغة العربية، سؤالا صادما تجاهله البعض ونلتفت له اليوم لأهميته الشديدة وقالت: لماذا العالم العربي غني بالمال وفقير في التكنولوجيا؟ وكتبت دويتشة فيله، إنه حتى الآن لم تتمكن أيّ دولة عربية من نقل "التكنولوجيا العالية والعالمية" إليها وإقامة صناعة تقوم على الابتكار، رغم الغنى الفاحش لبعضها؟!
وواصلت.. لماذا هذا التصحر التكنولوجي في العالم العربي؟ رغم توفر كفاءات فردية واستثمارات عربية ضخمة في الخارج؟ تقدر بنحو بنحو 2.4 تريليون دولار في الدول الصناعية والصاعدة، وفق تقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية التابع للجامعة العربية.
والحقيقة إنه سؤال محبط ومحزن، لماذا فعلا العرب وبكل هذا المال الوفير والموارد البشرية، حيث يبلغ عدد سكان العالم العربي نحو 430 مليون نسمة وفق آخر الاحصاءات؟ ليسوا مجتمعات صناعية متقدمة؟ لماذا نحن فقط شعوب مستهلكة ولا نقف في مرتبة تليق بالعرب على مستوى العالم؟
وواصلت دويتشة فيله توجيه الأسئلة، إنه رغم كل الاستثمارات العربية في الصناعات الغربية الرائدة طوال أربعة عقود مضت، غير أن كل هذه الاستثمارات في الغرب، لم تفلح في نقل "التكنولوجيا العالية" وتوطينها في أيّ دولة عربية حتى الساعة، ومن الأدلة على ذلك أنه لا يوجد سيارة أو هاتف أو كومبيوتر أو أي منتج آخر رائد وعالي التقنية "عربي" وذو سمعة عالمية يتناقله العالم.
ورغم أن إجابة الخبراء والاقتصاديين في تفسير هذا الفقر المعلوماتي والتكنولوجي والتخلف عن العالم، ردد بعض الإجابات الحقيقية والمعروفة منذ عقود على تفشي الفساد والرشوة والمحسوبية وسوء استغلال السلطة والبيروقراطية وغياب البنية التحتية، وهى المسؤولة بشكل مباشر عن عدم توطن التكنولوجيا العالمية في البلاد العربية حتى اللحظة. إلا أن هناك أسباب أخرى لا تقل أهمية عن هذه الأسباب، وهى غياب ثقافة العمل والتنظيم الجماعي وروح الانضباط وحرمان المبدعين من حقوق ملكيتهم الفكرية.
ويدعم هذا الرأي، وفق دويتشة فيله، خبرات بعض الدول الصاعدة وبالخصوص النمور الآسيوية وغيرها، والتي تمكنت من تحقيق اختراق تكنولوجي وصناعي هائل، رغم معاناتها من مشاكل الفساد والبيروقراطية وضعف البنية التحتية، ومن هذه البلاد تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وتشيلي والبرازيل وفيتنام. في حين لا يظهر أي أثر يذكر للدول العربية، وسط الدول الصاعدة في مجال نقل التكنولوجيا وتوطينها على أساس وطني ومتكامل. بالإضافةإلى أنه أنه لا توجد دولة عربية واحدة حتى الآن، قادرة على جمع كفاءاتها في إطار مشاريع تقوم على البحث والتطبيق والإبداع في نقل التكنولوجيا الأجنبية العالية وتوطينها محليا، وبهدف الإبداع لاحقا في إنتاج ما هو أحدث منها، وبشكل يلبي متطلبات السوق المحلية والأسواق العالمية كما فعل الصينيون والماليزيون والكوريون خلال العقود الماضية.
وينبهنا هذا التقرير الصادم، والمنشور قبل نحو عامين، إلى مشكلة اقتصادية كبرى وهى غياب التصنيع والتكنولوجيا في العالم العربي.
ومع المعاناة التي يعيشها العالم العربي اليوم، وضبابية المستقبل مع انهيار أسواق النفط وقد كانت المغذي الرئيسي للثروات العربية، وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة كمصدر رئيسي للدخل وهذه العوامل الثلاثة انهارت تقريبا، خلال هجمة فيروس كورونا، والتي ستستمر تداعياتها حتى منتصف العام المقبل والى حين تعميم لقاح فعال مضاد للفيروس عالميا والتصدي له، فهذا هو الدافع للسؤال.
إن مشكلة افتقادنا كعالم عربي، في أن نكون قوة اقتصادية وصناعية عربية، مشكلة كبرى ومأساة حقيقية لا تتعلق فقط بأكثر من 400 مليون عربي يعيشون الآن، ولكن بمستقبل عشرات الملايين من الشباب العربي خلال السنوات المقبلة وبحثهم عن حياة وفرص عمل.
فالعرب ليسوا فقراء ماليا، وفق مختلف التقارير العالمية علاوة على امتلاكهم الموارد البشرية والطبيعية، فلماذا لا نحقق اختراق تكنولوجي وصناعي عالمي؟
إنها باختصار مشكلة النهضة العربية بشكل عام، وثقافة المجتمعات العربية والعديد من الحكومات التي يجب أن توجه طاقاتها للتصنيع وتوطين التكنولوجيا، لس فقط بهدف إعادة تجميع بعض المنتجات، مثل السيارات والأجهزة المنزلية وغيرها، وهذا متواجد في الكثير من الدول العربية ولكن لتسجيل إضافة عربية ورفع مستوى دخل الشعوب العربية.
ولا يزال العالم وسيظل لسنوات طويلة قادمة، يتدارس بعض مفردات "النهضة الصينية" في العالم. فقبل نحو 20 سنة من الآن، لم يكن الاقتصاد الصيني ذا قيمة أو تهديد عالمي رغم ضخامة عدد سكان الصين، والذي يبلغ مليار و400 مليون نسمة، وكانت آنذاك دولة مثل فرنسا أو ألمانيا يمثل اقتصادها ضعف أو أكثر من ضعف الاقتصاد الصيني، رغم أن عدد السكان في الدولتين معا لا يشكل عشر عدد سكان الصين. لكن "العملاق الصيني" فعل المعجزة في 20 سنة فقط ، وفق مختلف الدراسات العالمية واصبح الاقتصاد الصيني، هو الاقتصاد الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفق إحصاء عام 2019. ففي وقت قياسي لا يتجاوز العقدين من الزمن، تحولت الصين العملاق الآسيوي، من دولة نامية إلى أكبر تهديد للهيمنة الأميركية على العالم.
وكشفت مجلة "موي نغوثيوس إي إيكونوميا" الإسبانية بعضا من تفاصيل وإمكانيات العملاق الصيني الذي أصبح العالم يحسب حسابه جيدا. حيث باتت الشركات الصينية تنافس نظيراتها الأميركية، على السيطرة على مختلف القطاعات والأسواق في العالم، إذ إنها لم تعد تتميز فقط بالقدرة على تصنيع منتجات رخيصة ومنخفضة الجودة، بل طورت شيئا فشيئا قدراتها، لتكتسب سمعة جيدة كمنتج للسلع ذات الجودة العالية.
وتمثل الصين اليوم، أكبر سوق لمنتجات الزراعة الأميركية، حيث إنها تشتري بقيمة 9.2 مليارات دولار من منتجات الفلاحين الأميركيين، ومن ضمنها هناك أكثر من نصف محاصيل الصويا، والصين اليوم ثاني أكثر بلد فيه مليارديرات في العالم، ففي العام 2018 كان في الصين 388 مليارديرا، أي أكثر من نصف العدد الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية وهو 680 ملياردير. وظهور هؤلاء الأثرياء في الصين، يؤكد أن البلد شهد نموا سريعا أكثر من أي بلد آخر.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن الصادرات الصينيةكانت تمثل 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، لكن في 2010 ارتفع هذا الرقم إلى 26%، وكانت ذروة الصادرات الصينية قد تحققت في 2006 عندما وصلت نسبتها إلى 36% من الاقتصاد الوطني.
كما أن متوسط دخل العائلات الصينية، ارتفع بنسبة 400% في 10 سنوات فقط، وخلال الفترة بين 2002 و2012 ارتفع متوسط دخل العائلة الصينية من 987 دولارا سنويا إلى 4273 دولارا، أي بنسبة 400%.
وغيرها من الأرقام التي تظهر، أن الصين تحولت إلى عملاق اقتصادي يهز العالم. واذا كان الغرب لديهم شركة أمازون الأميركية العملاقة، التي كسرت قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار، لتكون ثاني شركة في تاريخ البشرية تصل إلى هذه القيمة بعد "آبل" التي تصنع هواتف "آيفون"، فإن الصينيون اليوم لديهم مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة.
والخلاصة.. إنه إذا لم تكن نكبة كورونا محفزة للاقتصادات العربية مجتمعة، كي تغير طريقها، فإن أي أزمة مشابهة ووارد أن يحدث في هذا القرن 21، فقد تنهار كيانات عربية، وقد تشهد العشر سنوات القادمة اختفاء العرب كلية من على الخريطة العالمية أو بالأحرى اختفاء قيمة اقتصاداتهم وتواجدهم الهزيل.