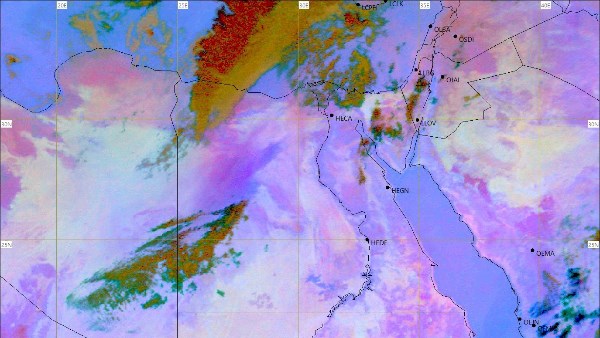كوم الزبالة

تقابلت في اليونان منذ خمس عشرة سنة مع أستاذ جامعي يوناني، وسعد بي للغاية عندما عرف أنني من مصر، حيث كنت له كنزًا ثمينًا ليختبر لغته العربية...واستهل كلامه معي بقوله: «زرت القاهرة أنا وزوجتى، وقد رأينا أكوام الزبالة في الشوارع، ورأينا عربات تجرها الحمير تحمل الزبالة»...قلت في نفسي كفى، لا تزيد يا صديقي، فبإمكاني أن أكمل لك المشهد...رجاءً ألا تعكر صفونا ونحن نرتوي من جمال بلادكم.
ومرت الأيام إلى أن طالعتنا الصحف بأن محافظة القاهرة ستتعاقد مع شركات عالمية لرفع القمامة من الشوارع، وسيتم وقف عمل جامعي القمامة من المنازل، الذين اعتدناهم سنينًا بزيهم الرث، ورائحتهم العطنة، وعرباتهم التي تعود إلى العصور الوسطى.
قلت في نفسي سأدعو ذاك اليوناني ليرى القاهرة في حُلتها الجديدة، حيث انتشرت صناديق القمامة الرمادية اللون في شوارعها، وجابت سيارات متخصصة ذات هيئة أوروبية مزودة بأطقم بشرية مبشرة بالخير شوارعها، وفي المقابل فرضت الحكومة على المواطنين رسومًا متباينة القيمة مقابل جمع القمامة.
بيد أن مأساة حلت بنا عندما بدأ أصحاب المحلات في الإجهاز على تلك الصناديق، كما قام الباعة وأصحاب الأكشاك بتحويل بعضها إلى ثلاجات لتبريد زجاجات المياه الغازية؛ فتفتق ذهن شركات النظافة عن استبدالها بصناديق حديدية عتيقة، ثقيلة، قميئة، أتوا بها من الألفية الأولى!
ورويدًا رويدًا بدأ الأداء في الإنخفاض، وأصبحت ظاهرة افتراش القمامة لشوارع المحروسة علامة على جبينها...وذات صباح قريب فوجيء الجميع باختفاء صناديق القمامة تمامًا من شوارع المحروسة...بعد أن أُنهيت التعاقدات مع تلك الشركات...وتاق المواطنون إلى البديل الأكثر حداثة، ودون طائل استمروا في دفع الجباية، وتمكنت من سائر شوارعنا القمامة، لتبدأ بكيس قمامة ملقى بجوار الرصيف لينمو ويكبر فيصبح كومة يصعب الاقتراب منها.
تذكرت كل تلك المشاهد التي اغتالت الجمال بيننا، وأنا أستمع إلى قصيدة للشاعر المميز د. عصام خليفة، أسماها "كوم الزبالة"، وكأنه يتحدث بلسان حال المصريين قاطبة، وليس سكان القاهرة فقط.
ولاشك أن اختيار الشاعر للعامية في هذه القصيدة جاء عمدًا ليقترب من الواقع الذي نعيشه؛ وفي تورية منه لم يكتف الشاعر بالإشارة إلى كومة قمامة افتراضية كانت تواجه متحفًا للحضارة، مما دفع المسؤولين ليقيموا سورًا يحجبها عن أنظار السائحين، بل ألمح أيضًا إلى نوع من البشر تشربت عقولهم ثقافة الزبالة، حتى أصاب مصر ما أصابها بسبب سوء قريحتهم، مما أدى إلى تعقد المشكلة وتفاقمها.
دعني عزيزي القاريء نقرأ جزءًا من تلك القصيدة البديعة، لعلها تُصلح ما أفسده الزمن، أو ترد الضمائر الغائبة إلى وعيها لتنقذ ما يمكن إنقاذه، بعد أن أصبحت "ثقافة الزبالة" واقعًا يستوجب التعامل معه:
...كل يوم الكوم يكبر
والزبالة تزيد وتكتر
اجتماع تانى لمجلسنا الموقّر
نعمل ايه ف قضية الكوم العنيد؟
رأى أول: ندعم السور بالحديد
رأى تانى: نعلى بيه مترين كمان
رأى تالت : يبقى نبنى سور جديد
رأى رابع :محتاجين نعمل دراسة.
فى الساعة دى
عضو مشهور بالفراسة
قال ياناس ده شىء بسيط
عيّنوا للسور حراسة
ما احنا لازم خارج الصندوق نفكر
قاموا برضه يصقفوا له
إنت رائع، إنت مبهر
والخلاصة
عينوا ف الركن حارس
كل يوم يصبح يمارس
الحراسة بشكل بائس
ناس تضايقه وناس تغافله
وناس بترمى عليه سخافة
ولاكتمال العبقرية
حطّوا لمستهم إضافة
يافطة فوق السور بتدعو للنضافة
والنضافة صار وجودها
زى اسطورة وخرافة
المصيبة إن القمامة رميها أصبح ثقافة
حتى نفس الحارس الواقف بحالته
كان بيرمي فيها زي الناس زبالته
هو ده أصل العبارة
هو ده سر الخسارة
والتأخّر والمشاكل
إن دى طريقتنا فى حل المسائل
يا أهلها يا طيبين
ياللى بتحبوا البلد دى من سنين
ياللى رافضين للروتين
ياللي قاريين حزنها ومتأثرين
يا اللي عاشقين للبلد دي ف كل حالة
مين يقول للعزم ياللا انهض تعالى؟
مين يكسر كل جدران الصعوبة والاستحالة؟
مين يغير كل أشكال التباتة، والبلاهة، والرزالة؟
مين يطهر كل شبر ف أرضها من كل عالة؟
مين يشيل كوم الزبالة؟