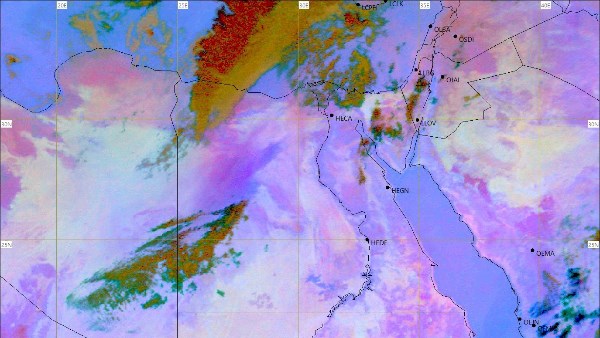"لا يمكننا حقًا أن نقول بأننا نعيش في عالم يسوده العدل والمساواة حتى يتمكن نصف سكاننا المتمثلين في النساء والفتيات من العيش في مأمن من الخوف والعنف ومن انعدام الأمن يوميًا". هكذا نشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة نقلًا عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وتبدأ القصة في العام 1993 حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذا الإعلان أعلنت تعريف العنف ضد المرأة، على نحو يجب أن يتمعن فيه الكثيرون لتعدد أنواع العنف وأشكاله، حيث قالت إنه:
"أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."
وتؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن. على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسي لحق الفتيات في التعليم وتعميمه فقط بل في النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالي وتؤدي إلى محدودية خلق فرص العمل للمرأة؛ في حين أن العنف القائم على نوع الجنس يمكن أن يحدث لأي شخص، وفي أي مكان، فإن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للخطر؛ على سبيل المثال، النساء المسنات، وحاملات صفات الجنسين، والمهاجرات، والمصابات بفيروس الإيدز، والمعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية وغيرهن.
وما يجب أن ننوه إليه هنا هو عدم جواز استخدام إحصائيات وأرقام الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الأسري عامة على مستوى العالم، لنطبقها على المرأة المصرية أو المرأة العربية عامة؛ حيث يختلف وضع المرأة في كل مجتمع عن الآخر، وفقًا لظروفه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ومستوى الثقافة والتعليم بين أبنائه. فالمرأة الأوروبية مثلًا، برغم تعليمها المتميز شكلًا ونوعًا عن المرأة الشرقية، ليس لديها نفس الحقوق والمزايا التي أتيحت للمرأة الشرقية في ظل الإسلام أو حتى في ظل المسيحية الشرقية التي نشأت في مجتمع محافظ يتسم بالتقاليد والأعراف.
بيد أنه سواء كانت المرأة شرقية أم غربية فلديها نفس المشاعر والأحاسيس بل والأمنيات أيضًا، التي يجب أن يضعها المرء قيد الاعتبار، وهنا قال خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: "استوصوا بالنساء خيرًا"، وهي المرأة التي شبهها بالقارورة الرقيقة حين قال: "يا أنشجة! رفقًا بالقوارير"؛ وهي التي شرط الله على الزوج إقامة العدل حتى يمكنه الزواج بأخرى، بل أوقف الله قوامة الرجل على قدر ما ينفقه على أهل بيته.
وأود أن أشير هنا إلى ضرورة أن تعي كل امرأة عظمة رباط الزوجية ومدى قدسيته سواء في القرآن الكريم أم في الكتاب المقدس؛ وأن الحياة السوية بين الزوجين يجب أن تسير وفق قناعة تامة بما قسمه الله للزوجين في جو من الحب والعطاء والتجاوب النفسي لاحتياجات كل طرف من الطرفين بقدر ما يستطيع المرء؛ ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار المتعة الحرام بديلًا عن قصور ما ينتاب تلك العلاقة المقدسة، أو أن يصبح العنف بين الزوجين حلًا مشتركًا للمشاكل الأسرية، بما يعكس توترًا أو قصورًا في التكامل الحسي أو النفسي بينهما. إننا بحاجة ماسة لإيقاف العنف بين الأزواج، وليس فقط ضد النساء، فكثير من النساء يقمن بأعمال عنف ضد الرجال، وكثير من الرجال يقومون بالاعتداء على النساء بما يخالف الدين والأعراف.
أذكر شابًا متعلمًا تحدث معي ذات يوم بأن زوجته تحبه كثيرًا، لدرجة اختلاقها المشاكل له؛ مما يدفعه إلى ضربها ضربًا مبرحًا إلى أن يصيبه الألم من كثرة الضرب...تعجبت وقلت لنفسي أي نوع من الحب هذا! لماذا ينحرف الرباط المقدس عن طريقه الصحيح؟ ومع هذا تستمر الحياة بين الطرفين لحاجة كل منهما إلى الآخر، أو لأن الزوجة صبورة لا تزال تأمل في تقويم زوجها وتهذيب سلوكه، أو لرغبتها في الحفاظ على مناخ أسري من أجل تربية الأبناء.
من هنا أدعو الجميع لضرورة نبذ العنف بكافة أشكاله بين الأزواج، نساءً ورجالًا؛ فالعنف من فعل الشيطان، والحب هبة من الرحمن.