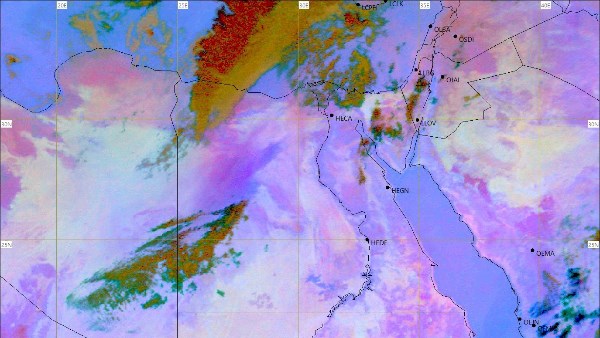في عام 1978م اصطحبني أحد أقاربي من هواة التمثيل إلى قصر ثقافة المنصورة، ولم أكن أعي جيدًا ماهية وأهمية قصر الثقافة، وماذا يمكن أن يشكل في حياتنا. وقد تخيلت أن قريبي دعاني لمشاهدة عرضًا مسرحيًا من العروض التي كانت تقدم بالأقاليم، حيث كان ديدن الفرق المسرحية خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي أن تقدم عروضها على مسارح المحافظات أو قصور الثقافة، بعد انتهاء عروضها بالقاهرة؛ مثل فرقة الفنان محمد صبحي، وثلاثي أضواء المسرح، ومحمد نجم، وسيد زيان وغيرهم، ممن قدموا عروضهم المسرحية بالأقاليم أيضًا.
دخلت المسرح وجلست بالصف الأول وإذا بقريبي قد بدل ملابسه ووقف على خشبة المسرح يؤدي دورًا ليس برئيسي في العرض المسرحي، وأخذت أتابعه باهتمام شديد. ولازلت أتذكر فرحته بعد أداء بروفة العرض واندماجه مع زملاء له "زي الورد" لنا أن نفخر بهم وبحماستهم المتقدة لإثبات ذاتهم.
أخذت أتابع بنهم لاحقًا أنشطة قصر الثقافة من عروض سينمائية، وعروض مسرحية، ومسابقات غنائية وفنية، وقراءة واطلاع وغيرها. وبانتقالي للعيش في القاهرة، أخذت في التنقل بين ربوع قصورها من قصر الأمير طاز إلى قصر المانسترلي إلى وكالة الغوري وغيرها لأشهد حراكًا ثقافيًا في تلك القصور جدير بالإحترام، من حيث الشكل والمضمون. ويتحتم علي أن أرفع القبعة للقائمين بالإشراف على تلك المنافذ الثقافية المهمة، التي لم أعد أعرف أنشطتها إلا صدفة من هذا أو ذاك.
وأعود أحن إلى مدينتى حبيبتي، التي تسكن الشق الأيمن من فؤادي، فتعبث بمهجتي، وتحرك الهوى بين جوانحي، كلما ذهبت إليها أو مررت بديارها. وأجد نفسي واقفًا أمام قصر الثقافة المنيف، لأستعيد ذكريات الأمس البعيد، وأهم بالسؤال عن هذا وذاك، لأوميء برأسي حزنًا على ضمور عضلاته، وشحوب وجهه، وكساد بضاعته، وانصراف عشاقه عنه. سألت عن المسرح القومي، فجاءتني الإجابة: عن أي مسرح تتحدث؟
وذات يوم قادتني الصدفة إلى مدينتي الثانية، التي تسكن الشق الأيسر من فؤادي، مدينة الفيوم، التي شهدت صباي وملهاي، تلبية لدعوة تلقيتها من قصر ثقافة الفيوم لحضور عرض فني لكورال الموسيقى العربية. وقد أدهشني ما رأيت من دقة العازفين ورقة الأصوات وعذوبتها، وتناغم أعضاء الفرقة مع بعضها البعض. كانوا يتطلعون لتقديم أجمل ما عندهم والظهور في أبهى صورة لهم، ومن شدة إعجابي أخذت أرقام هواتف مديرة النشاط وبعض مطربيها. وقد شطح بي الخيال أني سألقى هؤلاء ذات يوم على مسارح الأوبرا أو الهناجر أو غيرها من مؤسسات وزارة الثقافة من فرط جمال ما سمعت وشاهدت.
بيد أن مساحة الحلم كانت أوسع كثيرًا من الواقع. فقد مر عامان على هذه الدعوة لأكتشف بعد ذلك أن القضية ليست قضية أصوات أو مواهب وكفاءات، بل تكمن في أن تلك القصور تنفذ برامج نمطية (وظيفية) واجبة التنفيذ كل عام، لا تختلف كثيرًا عن كشكول تحضير المعلم بالمدرسة، الذي اختصر قضية التعليم في كمال دفتره وحسن تنظيمه.
والقضية هنا هي مسألة أداء وظيفي بحت في حدود المتاح، وليس البحث عن المواهب وصقلها وتصعيدها، وإحداث حالة من الحراك الفني والثقافي بين جدران تلك القصور، التي تملك كنوزًا بشرية فريدة تنشد من يهبها قبلة الحياة.
لاشك أن هناك الكثير من المعوقات التي تحول دون حدوث حالة من الإنطلاق الثقافي في الأقاليم منها محدودية إمكانيات قصور الثقافة، وضعف التمويل، ووجود آلاف من الموظفين العاملين بتلك القصور دون احتياج فعلي، وعدم توظيف أصول الهيئة توظيفًا مثاليًا، وغياب الرعاة من متذوقي الفنون، وغياب المسابقات الثقافية الجادة التي تشعل المنافسة بين الهواة والرواد، وغير ذلك من الأسباب التي أدت إلى ركود المنتج الثقافي بالأقاليم مع انحسار موجة الإبداع.
وأتساءل: ترى، هل تحتاج قصور الثقافة أن تدخل الإنعاش؟ أم تحتاج إلى تجديد الخلايا الجذعية حتى تعود إلى سابق مجدها حين كانت تسمى بالثقافة الجماهيرية؟ سؤالان أطرحهما، لعل هناك من يخرج علينا بالإجابة ممن يعوا خطورة دور تلك المؤسسات في بناء الإنسان.