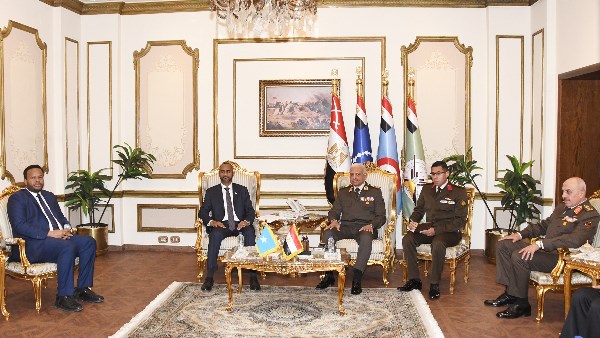الكم الهائل من المشاكل والقضايا التي تعاني منها منطقتنا من حروب ودمار وتناحر طائفي وقتل على الهوية لها أسبابها التاريخية والاجتماعية والثقافية والسوسيولوجية، التي نعاني منها ردحًا من الزمن. ولكن ما زلنا حتى راهننا نمضغ نفس اللبان والعلكة علَّنا أن نخرج من هذه القوقعة المميتة التي قضت على كل شيء مختلف وجعلت من المجتمع عبارة عن صندوق نمطي مليء برائحة العفونة القومجية المتعصبة.
يُقال إنه "من الغباء التكهن في الحصول على نتائج جيدة باتباع نفس الأسلوب الفاشل في تجارب سابقة"، وهذا ما يعاني منه معظم حكامنا.
حيث إنهم يصارعون العقل ويقاتلون الطواحين مثل دونكيشوت ويغتالون المجتمع للوصول إلى مجتمع متجانس يعمَّه الحرية والمساواة، وهم يستخدمون نفس الأساليب التي عفا عنها الزمن منذ وقت طويل.
استخدام العنف المفرط في تربية المجتمع اسلوب اتبعه الكثير من الحكام الاستبداديين ليطيلوا ديكتاتوريتهم المفرطة على المجتمع والإنسان على أساس أنهم أبديين ولن يتنازلوا عن السلطة للآخر.
منذ مئات السنين وتعيش المنطقة حالة الحروب والدمار والقتل والخراب والانقلابات العسكرية ويذهب نظام ويأتي آخر على أنه أقسم أن يكون أفضل من السابق، ولكن ما هي إلا أيام حتى يكرر ما سبقه بأسوأ مما كان. المشكلة أنَّ معظم الحكام مقتنعون في نفسهم أن أفضل من يُمثل المجتمع وأنه أذكاهم ولا أحد غيره بمقدوره أن يعتلي هذا الكرسي وهو بذلك يعتبر نفسه أبدي بعد أن يصنع حول نفسه هالة من الغرور المتعجرف بمشاركة مستشاري السلطان الذين يجعلونه "ظل الله" على الأرض.
وهذا ما رأيناه ونراه في معظم الرؤساء والحكام في منطقتنا التي باتت تئن منهم وتعمل على ازاحتهم من خلال مجتمعاتها.
التعصب القوموي والديني الذي أعمى بصيرتهم وقلوبهم هو الداء الذي ما زال المجتمع يعاني منه ويعيش سكرات الموت من هكذا حُكام.
فكثرة من يعتبرون أنفسهم ممثلين عن العروبة والاسلام وربط هذين المصطلحين ببعضهما بعُرى وثيقة، هو أكبر مصيبة حلت على مجتمعاتنا الغنية بالقوميات والأديان والشعوب التي تطلع دائمًا نحو العيش بكرامة وحرية.
هكذا تفكير شعبوي لا يمكن من خلاله بناء الإنسان الحر، بل على العكس من ذلك تمامًا. إذ، من خلاله لا يمكن الوصول إلا إلى مجتمع نمطي مستهلك متعصب لذاته واقصائي للآخر.
الـ "أنا" والـ "آخر"، "نحن" و "هم" هو أساس بناء أي مجتمع طبيعي منتج يمكن من خلاله أن يعبر الانسان عن ذاته ومكوناته وهويته الخاصة به من خلال وجود الآخر بكل ما لديه ويملك.
وأن الاختلاف في الرأي واللغة والثقافة والقومية ما هو إلا عنصر قوة واتحاد يمكن الاستفادة منه من أجل بناء الغد الجميل. بينما إقصاء الآخر وتحجيمه وصهره وإبادته تحت أي مسمى كان لا يمكن أن يكون إلا نوع آخر من الفاشية والنازية التي باتت من مخلفات القرن الماضي والتي راح ضحيتها ملايين من البشر.
إذ، لا يمكن أن توجد الـ "أنا" من دون وجود الـ "آخر". فهي علاقة تكاملية فلسفية مرتبطة بالوعي والإدراك لجوهر بناء المجتمع المختلف والقوي بآن واحدة. وحين تنتفي هذه العلاقة لا يمكن القول أن ثمة مجتمع هنا أو هناك، ما يتبقي لن يكون أبعد من مجتمع قطيع مستهلك وفاقد لذاته التي هي أساس وجود الـ "أنا".
فلا يمكن أبدًا إثبات وجود ثقافة ما من دون وجود ثقافة مجاورة لها، كذلك لا يمكن إثبات وجود الاسلام من دون وجود المسيحية وكذلك اليهودية، لأنها متممة لبعضها البعض وأي تعارض لهذا المبدأ، لن يخلصنا من دائرة العنف والاقتتال والدمار على أمور غير موجودة إلا في عقلنا المريض. كذلك بالنسبة للقوميات والاثنيات والثقافات بمختلف توجهاتها وآرائها. والأمر الهام هنا علينا الاعتراف به هو عقليتنا الذكورية التي لا ترضى إلا بذاتها وتنفي وجود الآخر أي المرأة إلا من خلاله هو. فلا وجود للرجل من دون امرأة وكذلك لا يمكن للمرأة ان تكون موجودة من دون رجل، لأنه منهما يتكون المجتمع.
للخروج من المجتمع النمطي الاستهلاكي القوموي المتعصب لا بد لنا قبل كل شيء بالقيام بثورة ذهنية واخلاقية. لأن أي ثورة مهما كانت لن تنجح إلا إذا بدأت بنفسها أي بنقد العقلية الشعبوية التعصبية والاعتماد على الثورة الذهنية التي هي أساس نجاح كل الثورات، وغير ذلك لا يُعتبر إلا سفسطة وديماغوجية ومُخادعة لذاتها ولمجتمعها ليس إلا.
الأمة الديمقراطية التي تحتضن في جنباتها كافة القوميات والإثنيات والأديان وتعمل على أساس أخوة الشعوب، هي الأمة التي تعترف بكل الثقافات وتعمل على إغنائها وتطويرها وتعتبر الاختلاف الخطوة الأولى نحو القوة والاتحاد. بعكس الأمة القوموية التي لا تعترف سوى بقوموية معينة أو دين بحد ذاته، والتي هي أي هذه الأمة هي سبب البلاء الذي نعيشه.
أي ينبغي الايمان أنه بدون الآخر لا يمكن أن أكون موجودًا أبدًا، وكذلك العكس صحيح. حينها يمكننا الحديث عن مجتمع معافي وغني وقوي.