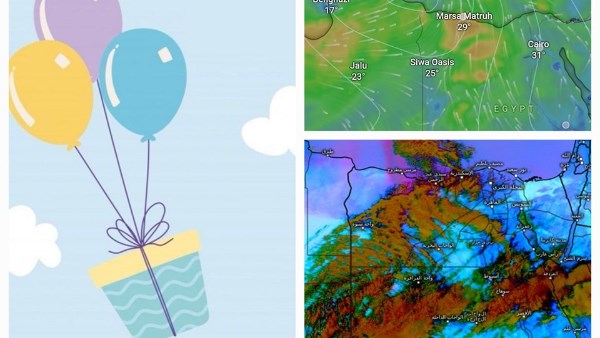36عاما على رحيل عبد الحليم محمود..شيخ الإسلام..وافته المنية عقب عودته من الحج ..ترك تراثا فكريا زاخرا..ينتهي نسبه للحسين

وُلد الشيخ عبد الحليم محمود في قرية "أبو أحمد" من قرى مدينة "بلبيس"، بمحافظة الشرقية سنة 1910م، والقرية منسوبة إلى جده (أبي أحمد) الذي أنشأ القريةَ وأصلحها، وتُسمَّى الآن باسم "السلام".
نشأ الشيخ الإمام في أسرة مشهورة بالصلاح والتقوى، وكان والده صاحب دينٍ وخلقٍ وعلم، ذا همةٍ عاليةٍ وثقافة، وكان ممن شغفوا بالثقافة الدينية وحلقات الأزهر العلمية، فدرس في الأزهر فترة طويلة، حضر فيها على كبار الأساتذة آنذاك، منهم: الشيخ محمد عبده، مما كان له الأثر في توجيه ابنه للدراسة بالأزهر.
حفظ الشيخ عبد الحليم القرآن الكريم في سِنٍّ مبكرة، مِمَّا أثار إعجاب مُحفِّظه وأهل قريته، والتحق بالأزهر سنة 1923م، وظل به عامين ينتقل بين حلقاته، حتى تم افتتاح معهد "الزقازيق" سنة 1925م، فألحقه والده به لقربه من قريته، ثم التحق بعدها بمعهد المعلمين المسائي، فجمع بين الدراستين، ونجح في المعهدين، ثم عُيِّن مُدَرِّسًا، ولكن والده آثر أن يكمل الشيخ عبد الحليم دراسته.
تقدم الشيخ لامتحان إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية فنالها عام 1928م في سنة واحدة، حيث يقول هو عن ذلك: "فلما نقلت إلى السنة الأولى من القسم الثانوي، رأيت أن الوقت فيها بالنسبة لي ضائع أو شبه ضائع لأن ما لدي من علوم ومعرفة تتخطى حدود المقررات في هذه السنة وما يليها".
وكانت نُظُم الأزهر فى ذلك الوقت تبيح للطالب بالسنة الأولى الثانوية، أن يتقدم مباشرة لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية من الخارج، ونجحت وأرضى ذلك آمال والدي وشعوره نحوي، والحمد لله" ، واستكمل الشيخ الإمام دراسته العليا، فنال العَالِمية سنة 1932م.
كان والده يحب أن يرى ابنه الشيخ عبد الحليم مُدَرِّسًا بالأزهر؛ لكنه فوجئ برغبة الشيخ المُلِحَّة في السفر إلى فرنسا؛ لإتمام الدراسة في جامعاتها، وذلك على نفقته الخاصة، وأخذ يحاول أن يثني الشيخ عن رأيه بشتى الوسائل، ولكن محاولاته لم تفلح.
وآثر الشيخُ عبد الحليم أن يَدْرس تاريخَ الأديان والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، وفي سنة 1938م التحق بالبعثة الأزهرية، التي كانت تَدْرس هناك، وقد تم له النجاح فيما اختاره من علومٍ لعمل دراسة الدكتوراه.
في البداية فكر الشيخ رحمه الله أن تكون رسالته في مجال يتصل بـ"فن الجمال"، لكنه رفض الموضوع، ففكر ثانيًا في أن تكون في مجال يتصل بـ"مناهج البحث" فرفض أيضًا، وبعد تجارِب هنا وهناك في مجالات مختلفة من الموضوعات، وبعد تردد في هذا الموضوع أو ذاك، هداه الله إلى موضوع "التصوف الإسلامي" ولم يكن هذا مصادفة، وإنما هى الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وكان موضوعها: "أستاذ السائرين: الحارث بن أسد المحاسبي"، وفي أثناء إعداد الرسالة قامت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر سنة 1939م، وآثر كثير من زملائه العودة، ولكنه بالإيمان القوي والعزيمة الصلبة أصرَّ على إتمام الرسالة، وكان له ما أراد.
نال درجة "الدكتوراه" بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وقررت الجامعة طبعها بالفرنسية يوم 8 من يونيو سنة 1940م .
بدأ الشيخ الإمام حياته العملية مُدَرِّسًا لعلم النفس بكلية اللغة العربية، ثم نقل أستاذًا للفلسفة بكلية "أصول الدين" سنة 1951م، ثم عميدًا للكلية سنة 1964م، وعين عضوًا بمَجمع البحوث الإسلامية، ثم أمينًا عامًّا له، وبدأ عمله بدراسة أهداف المَجمع، وكوَّن الجهاز الفني والإداري من خيار موظفي الأزهر، ونظَّمه خيرَ تنظيم، وأنشأ المكتبةَ به على أعلى مستوًى من الجودة، وبعدها أقنع المسئولين في الدولة بتخصيص قطعة أرض بحي "مدينة نصر" لتخصيصها للمَجمع؛ لتضم جميع أجهزته العلمية والإدارية، إلى جانب قاعات فسيحة للاجتماعات؛ فكان هو أولَ من وضع لبنات مجمع البحوث الإسلامية، كما اهتم بتنظيمه، وواصل الشيخ عبد الحليم محمود اهتمامه بالمجمع بعد تعيينه وكيلا للأزهر، ثم وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهر، ثم شيخًا للأزهر.
في سنة 1970م صدر قرار جمهوري بتعيينه وكيلا للأزهر؛ فازدادت أعباؤه، واتسعت مجالات جهوده، فراعى النهضة المباركة في مجمع البحوث، وبدأ يلقي محاضراته في كلية أصول الدين، ومعهد الدراسات العربية والإسلامية، ومعهد تدريب الأئمة، إلى جانب محاضراته العامة في الجمعيات والأندية الكبرى، بالقاهرة وغيرها من الأقاليم، وكان مع هذا كله يوالي كتابة الدراسات والمقالات في كبرى المجلات الإسلامية، ويواصل الدراسات ويصنف المؤلفات القيِّمة، ويشرف على رسائل الدكتوراه، ويشارك في المؤتمرات والندوات العلمية، وامتد نشاطه إلى العالم الإسلامي كله بنفس الهمة والنشاط.
اتسم الإمام الأكبر بغزارة إنتاجه الفكري الذي يربو على مائة كتاب، تأليفًا وتحقيقًا وترجمة، وكان أول ما نُشر له: قصة ترجمها عن الفرنسية، من تأليف أندريه موروا، ثم تتابعت مؤلفاته الغزيرة في كثير من المجالات، خاصَّة في مجال "التصوف" الذي يُعَدُّ من أسبق رواده في العصر الحديث، فقد تبدى مثالا للصوفية المُقَيَّدةِ بكتاب الله، البعيدة عن الإفراط والتفريط، حتى لُقِّبَ بـ"غزالي مصر" و"أبي المتصوفين"، فكانت كتاباته الصوفية لها الحظ الأوفر من مؤلفاته؛ فكَتَبَ "قضية التصوف: المنقذ من الضلال" والذي عرض فيه لنشأة التصوف، وعلاقته بالمعرفة وبالشريعة، وتعرض بالشرح والتحليل لمنهج الإمام الغزالي في التصوف، كما ترجم لعشرات الأعلام الصوفيين، مثل: سفيان الثوري، وأبي الحسن الشاذلي، وأبي مدين الغوث وغيرهم الكثير.
كما كتب في الفلسفة الإسلامية، ويعد كتابه "التفكير الفلسفي في الإسلام" من أهم المراجع التي تتناول علم الفلسفة من منظور إسلامي؛ حيث يؤرخ فيه للفكر الفلسفي في الإسلام، ويستعرض التيارات المذهبية المتعددة فيه؛ ليبين أصالة الفلسفة الإسلامية، وسَبْقَها الفلسفة الغربية في كثير من طرق التفكير.
كما تعرَّض للغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام في عدة كتب، مثل الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام" و"فتاوى عن الشيوعية".
كما ظهر اهتمامه بالسنة النبوية، فكتب العديد من الكتب عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وسنته، ويعد كتابه "السنة في مكانتها وتاريخها" من أهم كتبه في هذا المجال، كما كتب عن دلائل النبوة ومعجزات الرسول (صلى الله عليه وسلم).
واستعرض الإمام سيرته الذاتية في كتابه "الحمد لله، هذه حياتي" والذي جاء خلاصة لأفكاره ومنهجه في الإصلاح أكثرَ منه استعراضًا لمسيرة حياته، وعَبَّر عن منهجه التفصيلي في الإصلاح في كتابه القيم: «منهج الإصلاح الإسلامي في المجتمع".
كما قام بتحقيق الكثير من أمهات الكتب مثل "لطائف المنن" لابن عطاء الله السكندري، و"اللمع" لأبي نصر السراج الطوسي، و"المنقذ من الضلال" لحجة الإسلام الغزالي وغيرها.
وترجم العديد من الكتب في الفلسفة اليونانية والأخلاق، مثل "الفلسفة اليونانية أصولها وتطورها" لألبير ريفو، و"الأخلاق في الفلسفة الحديثة" لأندريه كريسون.
تولى الشيخ عبد الحليم محمود مشيخة الأزهر في ظروف بالغة الحرج، وذلك بعد مرور أكثر من 10 سنوات على صدور قانون الأزهر سنة1961م الذي توسع في التعليم المدني ومعاهده العليا، وألغى جماعة كبار العلماء، وقلص سلطات شيخ الأزهر، وغلّ يده في إدارة شئونه، وأعطاها لوزير الأوقاف وشئون الأزهر، فقد صدر قرار تعيين الشيخ الإمام عبد الحليم محمود شَيْخًا للأزهر في عام 1973م، وقد باشر فيه السعي لتحقيق أهدافه العلمية السامية، التي بدأها وهو أستاذ بكلية أصول الدين، ثم وهو أمين عام لمجمع البحوث الإسلامية، ثم وهو وكيل للأزهر، ثم وهو وزير للأوقاف وشئون الأزهر.
تولى الشيخ عبد الحليم محمود مشيخة الأزهر في وقت اشتدت فيه الحاجة لإقامة قاعدة عريضة من المعاهد الدينية التي تقلص عددها وعجزت عن إمداد جامعة الأزهر بكلياتها العشرين بأعداد كافية من الطلاب، وهو الأمر الذي جعل جامعة الأزهر تستقبل أعدادا كبيرة من حملة الثانوية العامة بالمدارس، وهم لا يتزودون بثقافة دينية وعربية تؤهلهم أن يكونوا حماة الإسلام.
وأدرك الشيخ خطورة هذا الموقف فجاب القرى والمدن يدعو الناس للتبرع لإنشاء المعاهد الدينية، فلبى الناسدعوته وأقبلوا عليه متبرعين، ولم تكن ميزانية الأزهر تسمح بتحقيق آمال الشيخ في التوسع في التعليم الأزهري، فكفاه الناس مئونة ذلك، وكان لصلاتها لعميقة بالحكام وذوي النفوذ والتأثير وثقة الناس فيه أثر في تحقيق ما يصبو إليه، فزادت المعاهد في عهده على نحو لم يعرفه الأزهر من قبل.
صدر قرار جمهوري كان استصدره وزير شئون الأزهر، كاد يسلب به من الشيخ كل سلطةٍ، ويجرِّده من البقية الباقية من نفوذه، فغضب الشيخ الإمام عبد الحليم محمود، لا لنفسه، وإنما غضب للأزهر، ولمكانة شيخه التي اهتزت، واهتز باهتزازها مقام الأزهر في مصر وفي العالم العربي، بل في العالم الإسلامي كله، فلم يجد الإمامُ بُدًّا من تقديم استقالته في سنة 1974م، ثم شفعها بخطاب آخر، قدَّمه إلى رئيس الجمهورية، شَارِحًا فيه موقفه، وأن الأمر لا يتعلق بشخصه، وإنما يتعلق بالأزهر وقيادته الروحية للعالم الإسلامي كلِّه، مبيِّنًا أن القرار الجمهوري السابق يغُضُّ من هذه القيادة ويعوقُها عن أداء رسالتها الروحية في مصر وسائر الأقطار العربية والإسلامية، وقبل هذا أخطَرَ وكيلَ الأزهر بموقفه؛ ليتحمل مسؤوليته حتى يتم تعيين شيخ آخر.
ورُوجع الإمام في أمر استقالته، وتوسط لديه الوسطاء فأصرَّ عليها كل الإصرار؛ لأن الموقف ليس موقف انتقاص من حقوقه الشخصية، وإنما هو انتقاص لحقوق الأزهر، وهضم لمكانة شيخه، ولو كان الأمر يتعلق بحقوق الإمام عبد الحليم محمود لتساهل فيه؛ لأنه صديق قديم لوزير شئون الأزهر؛ ولأنه بفطرته زاهد في المناصب، عازف عن المظاهر، منصرف عن متاع الحياة الزائل وزخرفها الباطل، مؤمن كل الإيمان بأن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابًا وخير أملا، فأَصَر على تقديم استقالته، وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، ورفض تناول راتبه، وطلب تسوية معاشه، ووجه إلى وكيل الأزهر - وقتها - الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار خطابًا يطلب منه أن يُصرِّف أمور مشيخة الأزهر حتى يتمَّ تعيين شيخ جديد.
وأحدثت الاستقالة آثارها العميقة في مصر وفي سائر الأقطار الإسلامية، وتقدم كثيرون من ذوي المكانة في الداخل والخارج يُلحِّون على الإمام راجين منه البقاء في منصبه، لكنه أبى، ولم يعُد لمنصبه إلا بعد إلغاء القرار وصدور اللائحة التنفيذية التي تخوِّل للأزهر شئونه.
يقول الإمام عبد الحليم عن نفسه بعد إعداده رسالة الدكتوراه: "بعد تردد بين هذا الموضوع أو ذاك، هداني الله - وله الحمد والمنة - إلى موضوع التصوف الإسلامي، فأعددت رسالةً عن (الحارث بن أسد المحاسبي) فوجدت في جوِّ (الحارث بن أسد المحاسبي) الهدوءَ النفسي، والطمأنينة الروحية، هدوء اليقين، وطمأنينة الثقة، لقد ألقى بنفسه في معترك المشاكل، التي يثيرها المبتدعون والمنحرفون، وأخذ يصارع مناقشًا مجادلًا، وهاديًا مرشدًا؛ وانتهيت من دراسة الدكتوراه، وأنا أشعر شعورًا واضحًا بمنهج المسلم في الحياة، وهو منهج الاتباع، لقد كفانا الله ورسوله كل ما أهمنا من أمر الدين، وبعد أن قرَّ هذا المنهج في شعوري، واستيقنته نفسي، أخذتُ أدعو إليه كاتبًا ومحاضرًا، ومدرسًا، ثم أخرجت فيه كتاب "التوحيد الخالص" وما فرحت بظهور كتاب من كتبي، مثل فرحي يوم ظهر هذا الكتاب؛ لأنه خلاصة تجربتي في الحياة الفكرية".
لم يكن تصوفه هروبًا من الحياة؛ بل كان علاجًا لمعضلاتها، لقد كان الشيخ عبد الحليم لا يفارق الناس إلا عند نومه، فهو يزور ويرحل، ويجتمع ويناقش، ويدفع إلى الخير، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر. والفرق بينه وبين سواه من النظريين، أنه يصدر عن يقين، وينفعل عن عقيدة، وينصح عن إدراك، وقد فهم رسالة المسلم في الحياة، فهم أنه خليفة في الأرض.
لقد اهتدى الإمام بعد عناء طويل في رحلته الفكرية إلى أن القلب موضع إقناع المؤمن، فالمؤمن لا يتطلب تغلغل العقل كي يقتنع، ولكنه يلتمس ماء الهداية كي يرتوي.
كان عالمًا حكيمًا، يدرس الوضع بدقة وإمعان، ويفكر في القضايا والمشكلات تفكيرًا جديًّا وسليمًا، ويبحث لها عن حلول في صمت، ويبدي رأيه في أوانه؛ لذلك استطاع أن يحفظ مكانة الأزهر ويُبقِي كرامته، لقد كان أمة في ذاته؛ فإذا جلس في مكان تحول ذلك المكان إلى مسجد ومدرسة، وكان الناس يؤمونه من الجهات البعيدة؛ ليستفيدوا منه العلم والدين والربانيَّة.
لقد قام شيخ الأزهر الإمام عبد الحليم محمود بجلائل الأعمال؛ وأجل من كل شيء هو صموده في وجه أي ظلم وطغيان، ورفضه بيع الضمير، إنه ثبت على عقيدته وإيمانه كالجبل الراسي، وألح على الحفاظ على مكانته عند الله، وعند الناس ولقد قام بإعادة اعتبار الأزهر ومكانته إلى النفوس، وأزال جميع العوائق والعراقيل التي وضعت في طريقه، وفتح باب الأزهر على مصراعيه للوافدين من طلاب العلم والدين؛ فعاد الأزهر من جديد إلى مكانة القيادة العلمية والتربوية في العالم الإسلامي.
ويعد الإمام الأكبر عبد الحليم محمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الإسلامي والتصوف في العصر الحديث، ولقب بـ"أبي التصوف" في العصر الراهن، والإمام الأكبر عبد الحليم محمود له عمق وغزارة في الآراء الفقهية، ودقة الاجتهادات؛ مما جعله يكسب صفوف المعارضين قبل المؤيدين، إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة في عرض أي موضوعٍ ومسألةٍ تتعلق بأمور الدين.
ثم كان من أمر الشيخ عبد الحليم أن أصبح هو الفضيل بن عياض، وهو الإمام الغزالي، وهو الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، حتى وصل به الأمر أن امتزج امتزاجًا كاملًا بالمدرسة الشاذلية فكان قطبها، ولقب بأبي الحسن الشاذلي القرن العشرين، ولقب أيضًا بـ"أبي العارفين" فلقد كان إليه المرجع والفتيا وريادة الفكر الإسلامي والتصوف في العصر الحديث.
توفى الإمام عبد الحليم محمود بعد عودته من رحلة الحج في 17 من أكتوبر 1978م قام بإجراء عملية جراحية بالقاهرة فتُوفِّيَ على إثرها، وتلقت الأمة الإسلامية نبأ وفاته بالأسى، وصلى عليه ألوف المسلمين الذين احتشدوا بالجامع الأزهر ليشيعوه إلى مثواه الأخير، تاركًا تُرَاثًا فِكْرِيًّا زَاخِرًا، ما زال يعاد نشره وطباعته.